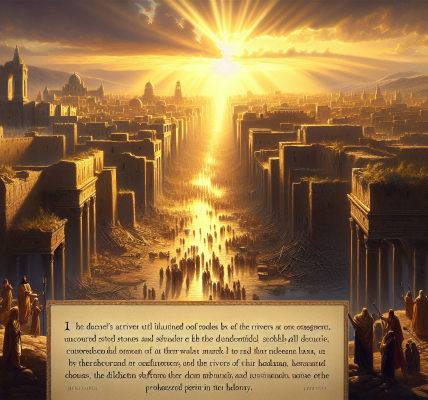كانت الشمس تلملم أشعتها الذهبية خلف تلال مَمْفِيس، حين جلس آدم العجوز تحت شجرة تين عتيقة، يروي لحفيده قصة الأجيال الأولى. كانت يداّهُ المرتعشتان تمسكان بعصا من خشب الزيتون، بينما عيناه الغائرتان تحملان ذكريات ألف عام.
“ابني”، همس بصوته الأجش، “لقد رأيتُ العالم يتغير من حولي كما تتغير ألوان السماء عند المغيب. حين خرجنا من الجنة، كنتُ أسمع دقات قلبي كأنها طبل يُنبئ بنهاية الزمان. لكن الرب لم يتركنا نهيم في ظلام اليأس.”
كان نسيم المساء يحمل عبق التراب المبلل بعد يوم حار. تذكر آدم كيف علّم أبناءه زراعة الأرض، وكيف كانت يداه تنقلان البذور من جيل إلى جيل. “شيث، يا قرة عيني”، قال للحفيد، “كان يشبهني في مشيته، لكن عينيه كانتا تحملان نظرة مختلفة، كأنهما تعرفان طريقاً لم أسلكه.”
مرت السنوات كسحب الخريف. مات آدم بعدما بلغ من العمر تسعمائة وثلاثين سنة، وترك وراءه حكمة تتناقلها الألسن. كان شيث قد صار رجلاً يحمل على كتفيه مسؤولية الأسرة البشرية الناشئة. في ليالي الصيف الطويلة، كان يجلس مع أبنائه حول النار، يحدثهم عن عدالة الرب التي لا تحابي أحداً.
“أنوش”، قال شيث لابنه ذات مساء، “الإيمان ليس مجرد كلمات نرددها، بل هو نهر يجري في أعماق القلب.” كان أنوش يستمع لأبيه وهو يحدق في النجوم المتلألئة، وكأنه يبحث عن إجابة لأسئلة لم يجرؤ على نطقها.
عاش أنوش تسعين عاماً قبل أن يرى قيدان، ابنه البكر، يفتح عينيه على عالم يزداد تعقيداً. كانت القرى الصغيرة قد بدأت تتشكل، والناس يتعلمون فنوناً جديدة. لكن قلب أنوش كان يشتاق إلى شيء آخر، إلى صلة أعمق مع خالقه. في أيامه، بدأ الناس يدعون باسم الرب، كمن ينادي حبيباً غائباً.
كان مهلليئيل طفلاً هادئاً، يمضي ساعات وهو يراقب النمل يبني مساكنه. عندما كبر، صار حكيماً بين قومه. كان وجهه يحمل سلاماً غريباً، وكأنه يعرف سراً لم يدركه الآخرون. “يا بني يارد”، قال لمّا حمل ابنه بين ذراعيه، “العالم مليء بالضجيج، لكن الحكمة توجد في السكوت.”
كبر يارد وسط عالم يتغير بسرعة. كانت المدن الأولى تبنى، والأصنام تبدأ بالظهور هنا وهناك. لكن قلب يارد بقي متعلقاً بتعاليم آبائه. عندما بلغ من العمر مئتي عام، رزق بابن سماه أخنوخ. كان الطفل مختلفاً، عيناه تشعان بنور غامض.
“أبي”، سأل أخنوخ وهو في السابعة من عمره، “لماذا يخاف الناس الموت؟” نظر يارد إلى ابنه محاولاً إيجاد إجابة، لكنه أدرك أن الصبي يحمل حكمة تفوق سنه.
سار أخنوخ في الدنيا وكأنه غريب عنها. كان يمضي أياماً في البرية، يصلي ويتأمل. في سن الخامسة والستين، جاءته رؤيا غيّرت مساره. رأى مخلوقات نورانية تسبح بحمد الخالق، فانكشف له سر الوجود. من ذلك اليوم، صار أخنوخ يخبر الناس عن الدينونة الآتية، عن يوم سيحاسب فيه الرب الأحياء والأموات.
“متوشلخ”، قال أخنوخ لابنه وهو يربت على كتفه، “الزمن كالسحابة، يمر سريعاً ولا يعود. لكن كلمة الرب تبقى إلى الأبد.” كان متوشلخ يستمع لأبيه وهو يتأمل في معنى الحياة والموت.
عاش أخنوخ ثلاثمائة سنة بعد تلك الرؤيا، يمشي مع الرب ويعلم الناس طريق البر. ثم جاء اليوم الذي اختفى فيه. بحثوا عنه في الجبال والوديان، لكنهم لم يجدوا جثته. “أخذه الرب”، همس الناس بخوف وإجلال.
ترك أخنوخ وراءه ابناً عظيماً هو متوشلخ، الذي صار أطول الناس عمراً. تسعمائة وتسع وستون سنة عاشها متوشلخ، شاهداً على تقلبات الأزمنة. في سنواته الأخيرة، كان يجلس تحت شجرة بلوط عتيقة، يروي لأحفاده قصة الأجيال التي سبقته.
“لامك”، قال لابنه ذات مساء، “رأيتُ العالم يتغير كما تتغير ألوان أوراق الخريف. لكن شيء واحد لم يتغير: رحمة الرب التي تظلنا كالسماء تظل الأرض.”
كان لامك رجلاً جاداً، يحمل في قلبه هماً عظيماً. عندما بلغ من العمر مئة واثنتين وثمانين سنة، رزق بابن سماه نوحاً. نظر إلى الطفل الصغير وعيناه تفيضان بالدموع، كأنه يرى في مستقبله شيئاً لم يره الآخرون.
“هذا يعزينا عن أعمالنا وتعب أيدينا”، قال لامك لزوجته، “من أجل الأرض التي لعنها الرب.”
كانت كلمات لامك نبوءة غامضة، كالغمام الذي يحمل في أحشائه مطراً لا يعرف الناس إن كان خيراً أم نقمة. ونوح الطفل نام في مهده، لا يدري أنه سيصبح آخر حلقة في سلسلة الأجيال الأولى، وأول أمل للبشرية الجديدة.
هكذا مضت الأيام، جيلاً بعد جيل، كل إنسان يحمل في قلبه شوقاً إلى الجنة المفقودة، وكل أب يهمس في أذن ابنه: “اذكر خالقك في أيام شبابك”، قبل أن يعود إلى التراب الذي أخذ منه.