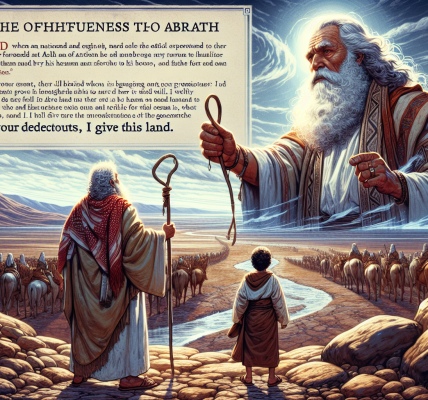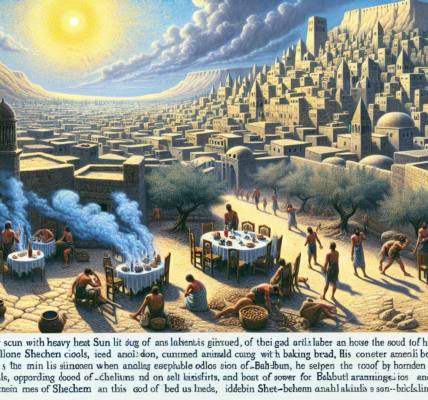كان الجو حارًا ثقيلاً ذلك النهار، حين غادر داود المدينة بأسرُه. كانت الشمس تميل نحو الغرب لكن وهجها ظل لاذعًا، يلطخ الأفق بلون نحاسي محترق. تحت أقدامهم، ارتفع غبار الطريق كسحابة خافتة تلتصق بالعرق والثياب. لم يكن هذا موكب ملك، بل كان زحفًا منهكًا لرجال مهزومين، ووجوههم تحمل ذلك الصمت الثقيل الذي يسبق الدموع.
تقدم داود قليلاً عن الجميع، مشيته متثاقلة لكن رأسه لم يكن منخفضًا. كان يستمع إلى حفيف خطى الجموع خلفه، وهمهمات الخدم، ونَهِيم الدواب. ثم، عند منحدر زائف، ظهر لهم رجل من بعيد، قادمًا من اتجاه قرية بعينها. كان يمشي بخطوات سريعة غاضبة، وكأنه يحمل نارًا في صدره. اقترب أكثر، فعرفوه: شمعي بن جيرا، من عشيرة شاول. وكان معه حصانان من أهل بيته، يقفان خلفه كما لو كانا حارسين لموكب عجيب.
وقف الرجل على حافة الطريق المرتفع، حيث ارتفعت الصخور كجدار مقوس. نظر إلى داود، ثم ملأ رئتيه هواء ذلك المساء الحار، وبصق. لم يكن البصاق مجرد رطوبة، بل كان فعلاً مقصودًا، مدروسًا، يسقط في الغبار أمام حوافر بغلة الملك. ثم رفع صوته، فكان كالصراخ الناشز في ذلك السكون الكئيب.
“اخرج، اخرج! أيها الرجل الدموي، أيها الرجل البليعال!”
كانت الكلمات كالسكاكين. رجال داود تحرّكوا، وأيديهم تقبض على أغماد السيوف. لكن داود رفع يده ببطء، كمن يمسك بخيط غير مرئي. فتجمدوا.
وواصل شمعي هتافه، وهو يرمي حجارة من أرض الطريق، حجارة صغيرة حادة كانت تضرب حول داود ورجاله، ترتفع منها نقرات خفيفة ثم تستقر. “لقد جَلَبَتَ عليك كل دماء بيت شاول، لأنك ملكت مكانه. والآن قد دفع الرب الملكية إلى أبشالوم ابنك. ها أنت في بليتك، لأنك رجل دموي!”
كان العار علنيًا، مكشوفًا كجرح نازف تحت الشمس. أبيشاي بن صروية، ذو النفس الحار كالفحم المتقد، اندفع نحو داود. “لماذا يسب هذا الكلب الميت سيدي الملك؟ دعني أعبر فأقطع رأسه!”
لكن داود أدار وجهه نحو أبيشاي. نظراته كانت متعبة، عميقة، كبئر شحيحة الماء. قال بصوته الخشن من التعب والسير: “ماذا لي ولكم يا بني صروية؟ دَعوه يسب. هو الرب الذي قال له: ‘إسبّ داود’. فمن ذا الذي يقول: ‘لماذا فعلت هكذا؟'”
ثم توقف لحظة، ونظر إلى بعيد، حيث كانت أورشليم تختفي خلف التلال كذكرى تتلاشى. أضاف والغبار يغطي شفتيه الجافتين: “هو ذا ابني الذي خرج من أحشائي يطلب نفسي. فكم بالحري هذا البنياميني الآن. دعوه يسب، لأن الرب قد قال له. لعل الرب ينظر إلى مذلتي، ويكافئني الرب خيرًا عوض سبه هذا اليوم.”
فمضى داود ورجاله في الطريق، وشمعي يسير على جانبه المقابل على حافة الجبل، يسب ويكرر الاتهامات، ويرمي التراب والحجارة، حتى بدا وكأن غيمة صغيرة من الغبار والشتائم تحيط بالموكب البائس. وكانت الشمس قد بدأت بالغروب، فطوّقتهم ظلال طويلة حزينة.
وفي تلك الأثناء، وصل أبشالوم وجميع رجال إسرائيل إلى أورشليم. وكان أخيتوفل معه. دخلوا المدينة في بهاء، كمن يدخل إلى ميراثه. لكن هيئة المدينة كانت غريبة، كبيت فارغ من روحه. فجأة، عند بوابة المدينة، جاء حوشاي الأركي، صديق داود القديم، بثياب ممزقة وتراب على رأسه، كعلامة الحداد.
نظر إليه أبشالوم، وسأله بمكر: “أهكذا تصنع بمحبتك لصاحبك؟ لماذا لم تذهب معه؟”
أجاب حوشاي بانحناءة خفيفة، لكن عينيه كانتا تقرآن وجوه الرجال حول أبشالوم: “لأنني للذي اختاره الرب وهذا الشعب وكل رجال إسرائيل، له أكون. وبعد ذلك، من الذي أخدم؟ أليس أمام ابن الملك؟ كما خدمت أباك، أكون خادمك.”
كانت الكلمات ناعمة، ملساء، دخلت أذن أبشالوم فاستقرت فيها. قبل به، وأصبح من مستشاريه. لكن في قلب حوشاي، كانت نار الولاء لداود تخبئ تحت الرماد.
ثم تقدم أبشالوم إلى أخيتوفل، سائلاً إياه: “أعط رأيك. ماذا نصنع؟”
كان أخيتوفل جادًا، صوته هادئًا لكنه قطعي، كصوت سيف يُسَل من غمده. “ادخل إلى سراري أبيك التي تركها لحفظ البيت. فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مُكْرَهًا لأبيك، فتتشدد أيدي كل الذين معك.”
فنُصِبَ لأبشالوم خيمة على السطح، ودخل إلى سراري أبيه أمام عيون كل إسرائيل. وكان ذلك الفعل، تحت جنح الليل، كختم من رصاص على تمرده، فأزاح كل غطاء من براءة مزعومة. وصرخات النساء المسلوبات لم تسمع، لأن صراخ المدينة الخائفة كان أعلى.
وهكذا، في ذلك اليوم، حمل داود عاره على الطريق الوعر كصليب من صمت وصبر. وحمل أبشالوم “نصره” كتاج من شوك وفضيحة. وكان الرب يسمع، ويرى، وينتظر في صمت السماوات.