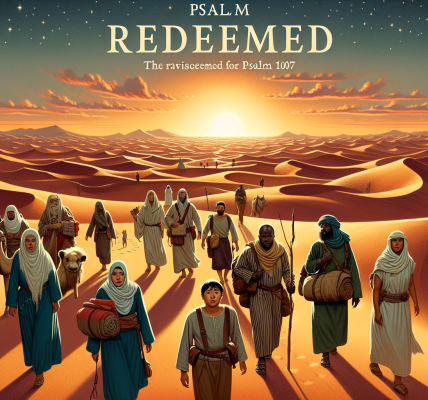كان الصباح يرسم ألوانه الباهتة على سفوح جبل الزيتون، وكان الهواء لا يزال يحمل لسعة الليل الأخيرة. وقف أولئك الرجال والنساء، قلوبهم مثقلة بما عاشوه، وأعينهم شاخصة إلى ذاك الذي كان، حتى اللحظة، واقفاً بينهم. كان قد قال لهم أموراً عديدة خلال الأربعين يوماً الماضية، أموراً عن ملكوت الله، أموراً بدت كأنها تلمح إلى عالم جديد على وشك أن ينفتح. لكن عقولهم، المعتادة على حِسّ الأرض وحدودها، كانت لا تزال تسأل بلهفة الطفل الذي يطلب علامة ملموسة: “يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟”
نظر إليهم، ونظرته تلك كانت تحمل شيئاً من الحزن العميق، حزن من يعرف أن السؤال نفسه ينم عن سوء فهم. أجاب بصوته الذي اعتادوا أن يسمعوه، ذلك الصوت الذي كان يهدئ العاصفة: “ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه.” كان كلامه يقطع الأوهام وينصّب الحدود بين ما هو إلهي وما هو بشري. ثم، وكأنه يفتح نافذة على مستقبل لا يتخيلونه، أضاف: “لكنكم ستنالون قوة، متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.”
كانت الكلمات الأخيرة تتردد في أسماعهم: “إلى أقصى الأرض”. كانت فسحة لا تُدرك، أوسع من كل أحلامهم القومية. وفيما هم منصتون، مأخوذون بوعده الذي لم يكتمل بعد، رأوا أمراً لم تستعد عيونهم له. رُفع ذلك الذي يحبونه، ببطء وجلال، بعيداً عن تراب الجبل الذي وقف عليه. لم يكن اختفاء سحرياً، بل كان صعوداً مرئياً، جسده يبتعد وهو يباركهم بيديه، حتى حالته سحابة عن أنظارهم، سحابة دخل فيها كما في حجاب ملكوتي.
بقيوا واقفين، مبهورين، وجوههم مرفوعة إلى السماء التي ابتلعته. دقائق طويلة مرت وهم لا يتحركون، كأنهم ينتظرون عودته في اللحظة ذاتها. وفي وسط ذلك الصمت المطلق، إلا من حفيف أوراق الزيتون القديمة، وقفا رجلان بثياب بيض لم يلحظوا وجودهما من قبل. كان ظهورهما مفاجئاً، لكنه لم يفلت من الشعور بالسلام. “أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء، سياتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء.”
كانت العبارة تذكيراً ووعداً في آن. فكسرت جمودهم. أداروا وجوههم عن السماء، ونظروا بعضهم إلى بعض. لقد عادوا إلى الأرض، إلى مهمتهم. نزلوا من الجبل، تلك المسافة القصيرة بين الزيتون وأورشليم، ولكنهم نزلوا وهم أناس مختلفون. خطواتهم كانت أكثر ثباتاً، صمتهم كان يحمل حديثاً داخلياً مع الذات الإلهية.
دخلوا المدينة، وصعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها. كانت غرفة واسعة، جدرانها حجرية تحمل عبق الأزمنة. كانوا هناك، مع النساء، ومنهم مريم أم يسوع، ومع إخوته. كان اجتماعاً لا ككل الاجتماعات. لم تكن هناك ضجة، ولا جدال عقيم، بل كانت “مواظبة بنفس واحدة على الصلاة والطلبة”. كانت صلواتهم تتعالى، خليطاً من الحمد والطلب والتساؤل الوجل. كانوا ينتظرون، ولكن هذه المرة لم يكونوا ينتظرون علامة زمنية، بل كانوا ينتظرون موعد الآب، ذلك الوعد الذي سيملأهم قوة.
وفي خضم تلك الأيام التي تلت الصعود، وقف بطرس بين الإخوة، وكان صوته يحمل ثقلاً جديداً، ثقلاً قيادياً نما من رحم الفشل والتوبة. تحدث عن داود، عن المزامير، عن الخيانة التي حدثت، وعن الحقل الذي اشتراه يهوذا بثمن الظلم. كان كلامه يربط الماضي بالحاضر برباط لاهوتي متين. “كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب”، قالها وكأنه يشرح فصلاً من فصول قصة أكبر، قصة الله مع البشر. اقترح أن يتم اختيار واحد ممن كانوا معهم طوال الوقت، منذ عماد يوحنا إلى يوم الصعود، ليكون شاهداً معهم للقيامة، ليشغل المكان الذي شغر.
فقدموا اثنين: يوسف المدعو بارسابا الملقب يوستس، ومتيا. ووقف الجميع يصلون، قلوبهم مرفوعة: “أيّها الرب العارف قلوب الجميع، عيّن أنت من هذين الاثنين أياً اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة.” ثم ألقوا قرعتهم، فوقعت القرعة على متيا. فانضم إلى الرسل الأحد عشر. لم يكن حدثاً درامياً بصخب، بل كان اكتمالاً هادئاً، كآخر قطعة في لوحة الفسيفساء، استعداداً للحدث الأعظم الذي لم يكونوا يعلمون كنهه بعد، لكنهم كانوا على موعد معه، في تلك العلية، حيث تهب الرياح من حيث لا يعلمون، وتأتي النار التي لا تحرق، بل تملأ وتوقد.