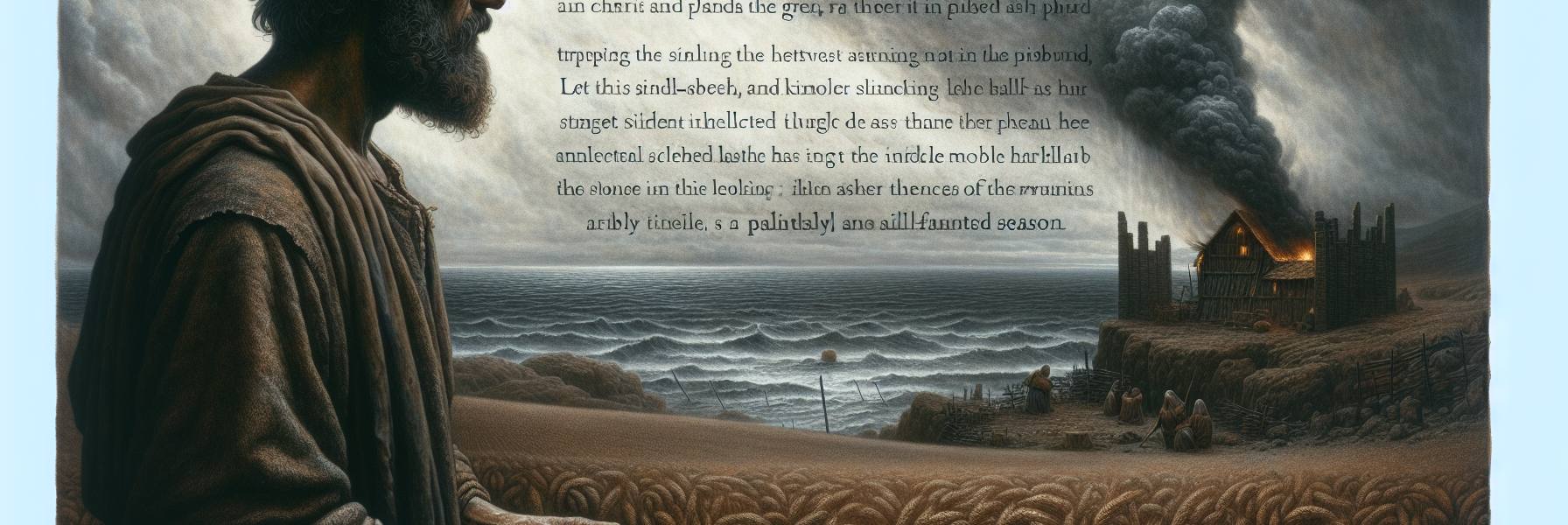كان النهار يُلفُّ قرية “أيلون” بحرارة ثقيلة، كأنها غطاء من صوف رطب. وقف “أليفاز” على عتبة بيته الطيني، يحدق في الأفق حيث كانت سحبٌ قاتمة تتجمع فوق حقله. لقد بذل كل ما في وسعه طوال الربيع، لكن قلقه كان أثقل من حر الصيف. قبل أيام قليلة، هبت عاصفة لم ير مثلها منذ سنوات، فاقتلعت أغصان أشجار الزيتون العتيقة، وحطمت جزءًا من سقف كوخ التبن. والآن، تُهدد السحبُ ما تبقى من زرعه القليل.
دخل إلى الظلمة النسبية للبيت، حيث كانت رائحة الطين البارد تختلط برائحة خبز الشعير. جلس على حصيرة منسوجة بإتقان، لكن يديه كانتا ترتجفان. لم يكن الخوف من الفقر وحده هو الذي يأكله، بل شيء أعمق: شعورٌ بالظلم القاسي، وموجة من الغضب الصامت تجاه السماء نفسها. “لماذا الآن؟” همس في قلبه. “ألم أحفظ وصاياك؟ ألم أقدم القرابين؟”. بدأ الشك يتسلل إليه كالأفعى، يتلوى في أعماقه: “أترى الله غير مهتم؟ أتراه يختبرني ليهزمني؟”.
في تلك اللحظة، سمع صوت خطوات خارج الباب. كان “باروخ”، الشيخ الحكيم الذي يعيش في الطرف الآخر من القرية قرب البئر. دخل باروخ ببطء، وحياته كلها محفورة في تجاعيد وجهه العميقة. لم يقل شيئًا في البداية، بل جلس قربه، ونظر إلى يد أليفاز المرتعشتين.
بعد صمت طويل، بدأ باروخ يتكلم، صوته خشن كحجر الطحن، لكنه دافئ: “رأيت السحب. ورأيت وجهك من النافذة. الغضب في عينيك مثل جمر تحت الرماد”.
انتفض أليفاز: “وماذا أفعل؟ أتهلل؟ كل شيء ينهار!”.
هزّ باروخ رأسه ببطء، وعيناه تبدوان وكأنهما تريان ما وراء الجدران. “لا تقل أن الله يجرّبك بالشر. فهو لا يجرب أحدًا. لكن شهواتك، حين تلتقي مع المحنة، تلد ذلك الولد المسموم: الشك، ثم الغضب، ثم السقوط. أتعرف ماذا يطلب منك؟ أن تثبت. الثبات وحده هو الذي يُتمم العمل”.
سأله أليفاز، وصوته يكاد ينكسر: “وكيف أثبت وأنا لا أملك حتى حكمة لأعرف كيف أصلح ما أفسدته؟”.
ابتسم باروخ ابتسامة خفيفة. “أطلبها. اطلب الحكمة من معطيها الكريم، الذي يعطي للجميع بلا عيب وبلا لوم. لكن اطلب بإيمان، لا مترددًا كموج البحر. لأن المتردد هو كغصن يابوس تحمله الريح هنا وهناك. ذلك الرجل لا يظن أنه ينال شيئًا من الرب”.
شعر أليفاز وكأن كلمات الشيخ تروي عطشًا كان يجهله. طلب الحكمة؟ نعم. ولكن بالإيمان الكامل، ليس بسؤالٍ ملؤه الشك. أغمض عينيه وصلى في صمت، ليس صلاة طويلة مزينة، بل صرخة بسيطة من الأعماق: “أعطني أن أرى يداك في هذه الخراب”.
لم تتغير الظروف فورًا. ففي اليوم التالي، كان عليه أن يعمل بجد لإصلاح السقف بمفرده، حاملًا الأحجار الثقيلة تحت وهج الشمس. وفي الأثناء، جاءه جاره يشكو منه لأن بعض الحجارة سقطت على مشارف أرضه. كان الغضب يغلي مرة أخرى في صدر أليفاز. تذكر كلمات باروخ: “ليكن كل إنسان مسرعًا في السماع، مبطئًا في التكلم، مبطئًا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله”. أمسك لسانه، واستمع لجاره حتى انتهى، ثم قال بهدوء: “سأصلح ما تلف من أرضك، وسأحترم حدوده”. دهش الجار من ردته، وانصهارغضبه في الخجل.
بدأ أليفاز يرى أن التجارب كانت تصقله، كالنار التي تفصل المعدن عن الخبث. لم تكن السعادة في الخراب ذاته، بل في ما كان يحدث في داخله: صبرٌ ينمو شيئًا فشيئًا، كالنبات البطيء. وأدرك أن هذا الصبر يجب أن يكون له فاعليته الكاملة، ليكون هو كاملاً وكاملاً، غير ناقص في شيء.
ذات مساء، بينما كان يجلس وحيدًا، جاءته فجأة. تلك الحكمة التي طلبها. لم تكن فكرة مجردة، بل فعل عملي. تذكر أن لديه مهارة في نحت الخشب، مهنة تركها منذ زمن بسبب الزراعة. ماذا لو صنع من أغصان الزيتون المقتلعة أواني صغيرة ومشغولات يبيعها في السوق؟ العمل الشاق والعرق سيبقيان، لكن الرجاء ولد من جديد.
مع الوقت، تعلم أن يكون سريعًا في الاستماع لمشاكل جيرانه، بطيئًا في إطلاق أحكامه، بطيئًا في الغضب. كما تعلم أن ينظف قلبه من كل رجس وفضيلة مرائية، وأن يقبل الكلمة المغروسة فيه، القادرة أن تخلص نفسه. ولكن أكثر من ذلك، أدرك أن الدين النقي عند الله الآب هو هذا: افتقاد اليتامى والأرامل في شدتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. فبدأ يزور أرملة عجوز في القرية، يساعدها في جلب الماء، ويشاركها قليلاً من طعامه، دون ضجيج.
في أحد الأيام، بعد سنة من العاصفة، كان واقفًا في نفس العتبة. لم تكن الحرارة أقل، لكن ثقلاً ما قد زال من على كاهله. الحقل لم يعد يروقه كما كان، لكن يديه كانتا تنحتان خشبًا جميلاً. نظر إلى السماء، ليس بتحدٍ أو بشكوى، بل باعتراف صامت: كانت المحنة قد أتمت عملها. لم يعد ذلك الرجل المرتعد من الداخل. لقد تعلم أن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبى الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. هو الذي شاء فولدنا بكلمة الحق، لكي نكون باكورة من خلائقه.
وعلم أليفاز، في قرارة نفسه، أن يصبح مستمعًا للكلمة عاملاً بها، لا سامعًا فقط يخدع نفسه. لأن من يسمع الكلمة ولا يعمل، فذلك يشبه رجلاً ينظر إلى وجه خِلْقته في مرآة، ثم ينصرف عن حاله وينسى كيف كان. أما الذي يتأمل في الناموس الكامل، ناموس الحرية، ويواظب عليه، لا يكون سامعًا ناسيًا، بل عاملاً بالعمل، فهذا يكون مغبوطًا في عمله.
وهكذا، تحت شمس فلسطين التي لا ترحم، نما قديسٌ بسيط، لا في مظهره الخارجي، بل في قلبه الذي تعلّم أن يفرح عندما يقع في تجارب متنوعة، لأنه عرف، أخيرًا، اختبارًا حيًا لما كتبه الحكيم: “إذ يعلم أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرًا. وأما الصبر فليكن له عمل تام، لكي تكونوا تامين وكملاء، غير ناقصين في شيء”.