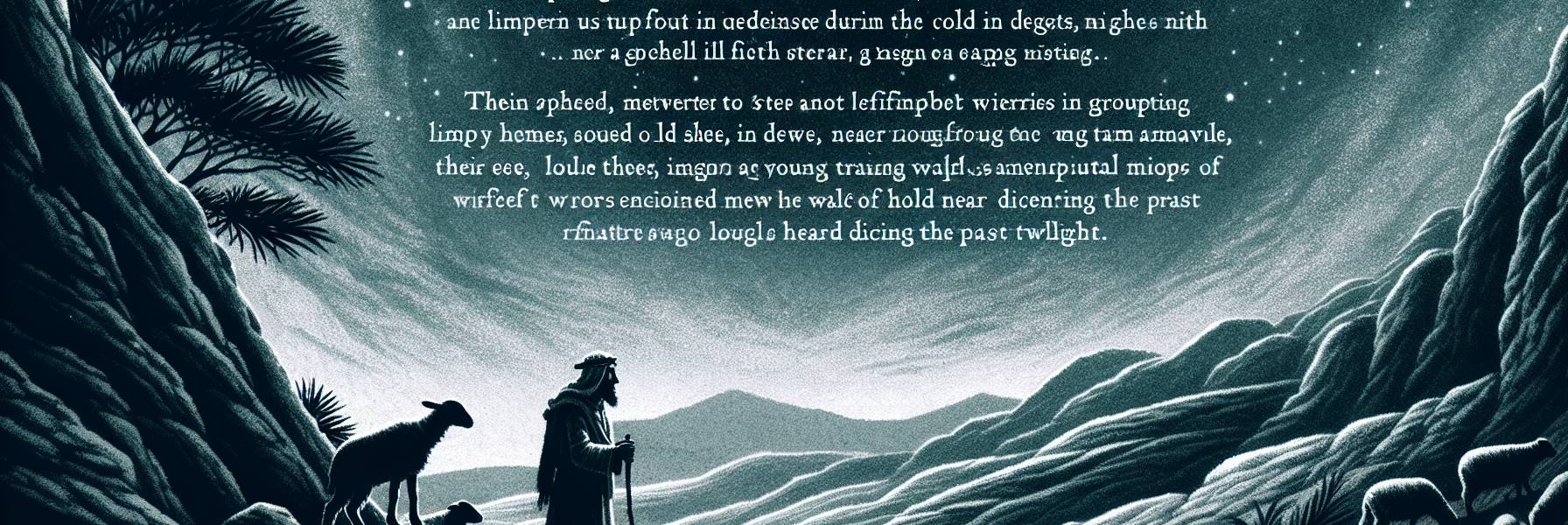كان الظلام قد أرخى سدوله على الوادي، والبرد القارس ينساب من علوّ الجبال كأنه نسمة تذكر كل كائن بحكمة الخالق. كان داود جالساً على حجر أملس بجانب غنماته النائمة، يتنفس الهواء النقي الذي يعبق برائحة إكليل الجبل البري. نظر إلى الأعلى، فانبهر.
لم تكن تلك السماء التي يعرفها في ليالي الصيف الدافئة. كانت ليلة شتوية صافية، كأنما غسلها مطرٌ حديث، فأصبحت قبة سوداء مرصعة بجواهر لا تحصى. تلمع النجوم كفتاتيل مصابيح معلقة بيد خفية، بعضها يرمش بوداعة، وبعضها يتألق بجبروت، وكأنها عيون تراقب الأرض في صمت مهيب. عبر درب التبانة شريطٌ من ضباب نوراني، كأنه نهر من لبن متجمد سال بين ضفاف الظلمة. وتوسط هذا المشهد القمر، ليس بدراً كاملاً، بل هلالاً دقيقاً كالابتسامة، ينثر ضوءه الفضي الخافت على صخور الوادي، فيجعلها تبدو وكأنها قطع من الفضة الخام.
وفجأة، كما لو أن القلب لا يحتمل هذا الجمال، انطلقت من أعماق داود كلمات، همساً في البداية ثم صارخاً في الفضاء الواسع:
“يا رب سيدنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض!”
لم تكن الكلمات مجرد حروف، بل كانت زفرة روح تواجه الجلال. فالصوت الذي خلق هذه النجوم اللامتناهية، هو نفسه الذي يسمع صوت الطفل الرضيع. إن عظمة الخالق لا تبتعد عن ضعف المخلوق، بل تحتضنه.
تابع يتأمل، وعيناه تسبحان في هذا المحيط النجمي: “إني أرى سماواتك، عمل أصابعك”. تخيل الأصابع الإلهية تضع كل نجم في مكانه، بدقة وحكمة، كمن يرصع تاجاً لملك عظيم. القمر والنجوم، هذا الجيش الهادئ المنتظم، يسير بأمره، ولا يحيد عن مساره طرفة عين.
وهنا جاء السؤال الذي يختلج في صدر كل إنسان واجه سعة الخليقة وضآلة ذاته:
“ما الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟”
الشعور بالضآلة كان ساحقاً. هو، داود، الراعي الذي ترعاه الغبراء والريح، ما قيمته في هذا الكون الفسيح؟ الغنمات حوله نائمة بسلام، وهي لا تعلم أن راعيها يشعر بثقل الوجود. لكن النظرة لم تتوقف عند هذا الحد. تذكر كلمات أبيه يسّى عن الخليقة، وكيف خلق الله آدم وحواء وسلّطهما على كل شيء. فانقلبت الفكرة في قلبه.
“لقد جعلته قليلاً دون الملائكة”، نعم، هو ليس ملاكاً، هو من تراب، يحمل ضعف الجسد وحاجاته. لكن هذا التراب توج “بالمجد والبهاء”. إنه ليس حيواناً ضالاً في البرية، ولا نجماً ساكناً في السماء. إنه كائن مخيّر، ناطق، يحمل في صدره شرارة من روح الخالق.
“أسلمته لتسلط على أعمال يديك”. نظر إلى غنماته، ثم إلى الجبال البعيدة، وإلى نهر الأردن الذي يلمع في ضوء القمر. كل هذا مسلَّم للإنسان. الطير في السماء، والسمك في البحر، وكل ما يدب على الأرض. السلطة هنا ليست استبداداً، بل أمانة. وكأن الله، بعد أن أبدع هذا الكون المعقد الرائع، قال للإنسان: “هذا هو منزلك، اعتنِ به، وأحكمه بحكمتي”.
“كل شيء وضعته تحت قدميه”. الكلمات الأخيرة كانت تملأ فضاء الليل برنين من الفرح الممزوج بالمسؤولية. لم يعد يشعر بالضياع، بل بالانتماء. لم يعد يراقب السماء كغريب، بل كابنٍ يدخل بيت أبيه الفخم فيجد أن الأب قد أعطاه مفاتيح كل غرفة.
سكت. صعدت من الوادي نسمة باردة حاملةً عواء ذئب بعيد. لكن الخوف لم يعد يسكن قلب داود. فهو يعلم أن الذئب، والنجم، والجبل، والإنسان، جميعهم تحت سيادة الحكمة الإلهية نفسها. رفع وجهه مرة أخرى نحو السماء اللامتناهية، وابتسم. إن صانع هذا الجمال العظيم، قد نظر إليه، وذكر اسمه، وكرّمه. ففي وسط ضخامة الخليقة، وجد الإنسان أنه ليس ضالاً، بل هو مقصود، محبوب، ومكلّف بمهمة جليلة.
وبينما كان الفجر يبدأ بشق حافته الذهبية خلف الجبال الشرقية، عاد داود إلى كوخه الحجري، وكأنه يحمل في قلبه سراً عظيماً: أن اسم الرب العظيم في كل الأرض، يتردد صداه، ليس فقط في هدير الشلالات وجبروت العواصف، بل أيضاً في قلب الإنسان الضعيف، عندما يرفع عينيه ويتأمل، ويعرف من هو، ومَنْ هو ربه.