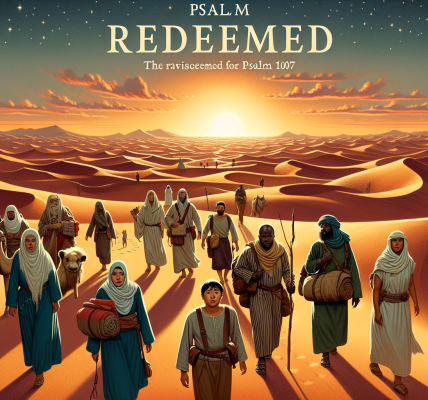كان الجوّ ثقيلاً في ذلك المساء، كأنّ السماء نحاسيّة تحبس أنفاسها. جلستُ قرب الشاطئ، أرمق الأمواج وهي تتكسّر على صخور بطمس بصوتٍ رتيبٍ أشبه بأنين. رائحة الملح والطحالب تملأ فضاء المكان، وصرخة نورسٍ وحيد تثقب صمت الغسق. كانت الذكريات تتزاحم: وجوه أحبّة في أفسس، أصوات تسبيح في سميرنا، همسات صلاة في برغامس. ثمّ، فجأة، دون مقدّمة، أحسستُ بحضره.
لم يكن نوراً يُعمي، ولا رعداً يُرهب. كان كصوت ماءٍ غزيرٍ جارٍ، نديّ، حيّ. التفتُّ فإذا سبع منائر من ذهب، وفي وسطها شبه ابن إنسان. لكنّ وصف “الشبه” هذا لا يفي بالحال. كان كالنور الذي ينفذ من وراء حجاب، أو كالصوت الذي يسبق الكلمة. رداؤه يصل إلى القدمين، ومنطقة من ذهب حول صدره. رأسه وشعره أبيضان كالصوف، كالثلج، وعيناه كلهيب نار. قدماه كالنحاس النقيّ كأنّه قد أُحمي في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة.
أمسكتُ بيمينه السبع كواكب، ومن فمه يخرج سيفٌ ذو حدّين ماضٍ. لمستُ قدميّ كخزفٍ يتهيّأ للكسر، وهمستُ: “يا رب”. فكانت كلماته الأولى تُقطّر كالطلّ على قلبي المحترق:
“اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس”.
تذكّرت حالاً تلك المدينة العظيمة، شوارعها المرصوفة بالرخام، هيكل أرطاميس الفخم، وسوقها الصاخب حيث يختلط بيع التماثيل الفضّية مع صياح الدجّاج. ووسط هذا كلّه، جماعة صغيرة تلتقي في بيت أكيلا وبريسكلا، أو في ظلّ أحد البساتين خارج الأسوار.
“أنا عارفٌ بأعمالك، وتعبك، وصبرك”. كان صوته يخترق الزمان والمكان، كأنّه يرى كلّ جلسة مسائيّة، كلّ دمعة سكبت في الخفاء، كلّ مجهود لبَذْلِ الذات. “وكيف أنك لا تطيق الأشرار، وقد جرّبت الذين يقولون إنهم رسل وليسوا، فوجدتهم كاذبين”. تذكّرت وجوهاً كثيرة أتت بأقوال معسولة، بادّعاءات عن أسرار وروحانيّات، وكيف كان الإخوة هناك أشدّاء كالصيّادين الماهرين، يميّزون الشبكة الجيّدة من الممزّقة.
“ولديك صبر، وتحمّلت من أجل اسمي، ولم تكلّ”.
كان المديح عظيماً. لكن ثمّة وقفة في الصوت، كفرجة بين النور والظلّ. “لكن عندي عليك: أنك تركت محبّتك الأولى”. لم تكن العبارة صرخة توبيخ، بل همسة حزن. كصديق يرى أخاه وقد جفّف ينبوع قلبه. تذكّرت الأيّام الأولى في أفسس، كيف كانت المحبّة تتدفّق عفوية، بسيطة، كالنهر في الربيع. ثمّ صارت الأمور ترتيبات، ولاهوتاً جافّاً، وغيرة بلا رحمة. الصّبر بقي، والتعب بقي، لكن العطر الذي يعطّر التعب ويحلّو الصّبر ذهب.
“اذكر من أين سقطت، وتُبْ، واعمل الأعمال الأولى”. الكلمات واضحة، صريحة، تشقّ القلب كالسيف الذي رآه يوحنا يخرج من فم المسيح. “وإلا فإني آتيك قريباً وأُزيل منارتك من مكانها”. إنّها ليست تهديداً انتقامياً، بل نتيجة طبيعيّة. ما فائدة المنارة إن لم تعد تنير بمحبّة؟ ما قيمة الشهادة إن جفّ ينبوعها؟
لكن حتى في هذا التحذير القاسي، تلمع نعمة. “ولك هذا: أنك تبغض أعمال النيقولاويّين التي أبغضها أنا أيضاً”. فالتقوى لا تكتمل بكراهية الشرّ فحسب، بل ببغض أعماله. كان ذلك اعترافاً بأنّ في القلب بقية أمانة.
ثمّ النداء الأخير، ذلك النداء الذي يتردّد في كلّ رسالة، كاللازمة التي تربط السماء بالأرض: “من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس”. هو لا يكلم منظّمات، بل أشخاصاً. أفراداً لهم أذن للسماع، وقلب للطاعة.
“من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله”. رأيتُها للحظة. ليس فردوس أرضيّاً، بل فردوس الله. شجرة الحياة، لا شجرة معرفة الخير والشرّ. العودة إلى النقطة التي بدأ منها كلّ شيء، لكن عبر الغَلَبة، عبر الصليب، عبر التوبة. الغَلَبة على الذات التي نسيت محبّتها، على الروتين الذي خنق الابتهاج، على الاتّكال على الأعمال المجرّدة.
انتهى صوت المياه الجارية. بقيتُ جالساً على الشاطئ، ونورس آخر يصرخ في المسافة. رائحة الملح نفسها، وصوت الأمواج نفسه. لكنّ شيءً ما تغيّر. كلمات الرسالة إلى أفسس كانت قد نُقشت، ليس على درج فقط، بل على قلبٍ يحتاج إلى تذكّر، إلى توبة، إلى عودة. والسبع منائر ما تزال تضيء، وابن الإنسان ما يزال يقف في الوسط، عيناه كلهيب نار، يرى كلّ شيء، ويعرف كلّ شيء، ويُحبّ رغم كلّ شيء.