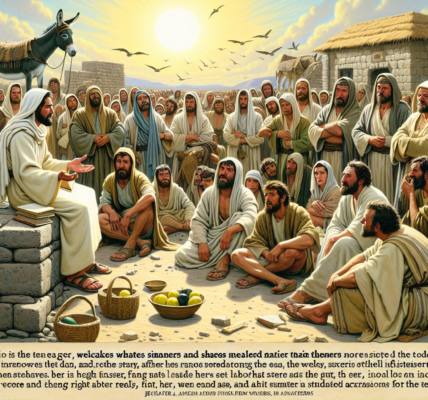كان الجو ثقيلاً في ساحة الهيكل، والغبار الذي ثار من أقدام الجموع الكثيفة لا يزال عالقاً في الهواء المشبع برائحة الخوف والرجاء. وقف نحميا أمامهم، ولفافة الشريعة محكمة بين يديه، لكنه لم يفتحها اليوم. فالكلمات التي سمعوها بالأمس كانت لا تزال ترن في آذانهم، كدوي رعد بعيد يهز أعماق الروح. لقد عادوا، بعد طول سبي، إلى هذه الأرض، لكنهم أدركوا بالأمس فقط كم كانوا بعيدين عن شرائعها، عن عهدها.
كان ذلك الصباح، بعد أن جثوا على وجوههم باكين، بعد أن اعترفوا بخطايا آبائهم وخطاياهم، جاءهم نحميا بكلمات لم تكن توبيخاً، بل خيط نور في ظلام الدهر. قال: “اليوم هو يوم مقدس للرب. لا تحزنوا، لأن فرح الرب هو قوتكم”. ثم أعلن عن فعل سيخلد هذه اللحظة، ليس مجرد بكاء عابر، بل عهدٌ يُكتب.
وها هم الآن، الكهنة واللاويون والرؤساء، وأمامهم كل رجل وامرأة ممن بلغ سن الفهم، يقتربون الواحد تلو الآخر. في وسط الساحة، وضعت لفافة كبيرة من جلد ماعز، ناصعة البياض، مستعدة لاستقبال الأسماء. كان الكاتب “متيثيا”، رجل عجوز انحنى ظهره من طول دراسة النصوص، يجلس أمامها، وأصابعه المرتعشة تلمس ريشة الكتابة. لم تكن تلك رعشة ضعف، بل هي الهيبة ذاتها التي تجعل اليد تتردد قبل أن تنقش شيئاً سيبقى إلى الأبد.
اقترب أولا “شكنيا” الكاهن، ووجهه جادٌ كيوم الغفران. سمعت همسة بين الحاضرين: “هو الذي صلى طوال الليل”. وضع إصبعه على المكان المخصص، ونظر إلى نحميا، ثم إلى السماء، كأنه يستمد عوناً من العلاء. غمس متيثيا الريشة في المحبرة السوداء الكثيفة، وبدأ يكتب: “شكنيا بن حرشيا”. بدت الأحرف وكأنها تنحت في الجلد، لا تكتب عليه. تبعه الكهنة: “عزريا، حننيا”، وأسماء أخرى ملأت السمع بتتابعها الجليل.
ثم جاء دور اللاويين. وقف “يشوع” الشاب، ابن العازار، وكانت عيناه تلمعان بحماسة طفل رأى الحلم يتحقق. تذكر كيف كان جده يحكي عن مجد الهيكل الأول، وهو يذرف الدمع على خرابه. الآن، سيُكتب اسمه على وثيقة إعادة البناء. وقبل أن يوقع، التفت إلى الجمهور، وصاح بصوت جهوري: “نعدك يا رب على السهر على أبواب بيتك، وعلى تلاوة توراتك في كل صباح ومساء!” فاهتزت الجموع تأييداً، وارتفع هتاف: “آمين!” كان هذا الخروج عن النص المتوقع، هذه اللفتة العفوية، هي ما جعل المشهد حياً، لا مجرد طقسٍ جامد.
تقدم الرؤساء بعد ذلك. كان بينهم “فحث موآب”، الرجل الثري صاحب البساتين الكثيرة. تردد لبرهة، وكانت علامات الصراع بادية على محياه. فالعهد لم يكن كلمات عاطفية فحسب؛ فقد قرأوا بنوده بوضوح. كان هناك تعهد بعدم الزواج من شعوب الأرض، وبتقديم الباكورات والأعشار بلا تقصير، وبإيقاف العمل والتجارة في السبت. كل هذا قد يكلفه خسائر في المال والعلاقات. نظر إلى الأرض، ثم إلى السماء. ربما رأى في مخيلته أبناءه وهم يسألونه: “لماذا نحرم من تلك المصاهرات المفيدة؟” ولكن الذكرى التي سمعوها بالأمس، ذكرى الخطايا التي أودت بالمملكة إلى السبي، كانت أقسى. نفَسَ نفساً عميقاً، ووضع إصبعه. كان توقيعه أكبر من غيره، وكأنه يريد أن يطبع القرار في داخله قبل أن يطبع اسمه على الجلد.
وهكذا تدفق الناس، العائلات بأكملها. كانت هناك امرأة، اسمها “حنة”، أرملة فقيرة، تقدمت وهي تحمل ابنها الصغير على كتفها. قالت للكاتب: “اكتب اسمي واسم ابني، يا سيدي. فلو لم يكن له أب يعلمه العهد، فلتكن هذه اللفافة أماً وأباً له”. ساد صمت مطرق عند سماع كلماتها. كانت هذه التفاصيل الصغيرة، غير المسجلة في السفر، هي لبّ الحدث.
ومع مرور الساعات، تحت وهج الشمس الذي صار يحمل بعض اللطف مع اقتراب العصر، امتلأت اللفافة. لم تكن قائمة جافة، بل كانت سجلاً حياً للوجوه والأصوات والقصص. جاء بنو “عزجاد” و”بناي”، و”بني” و”عزنا”، وغيرهم كثيرون. كان بعضهم يوقع وهو يهمس بصوت خافت بصلاة، وآخر وهو يربت على كتف جاره بابتسامة توثق أخوة أعمق من أخوة الدم.
ثم قرأ نحميا بنود العهد بصوت عالٍ، وكل بند كان يشعل تأكيداً جديداً من الحاضرين:
“وأن لا نعطي بناتنا لشعوب الأرض، ولا نأخذ بناتهم لبنينا”. صاحوا: “نعد!”
“وأن شعوب الأرض الذين يجلبون البضائع وكل غلال يوم السبت للبيع، لا نشتري منهم في السبت ولا في يوم مقدس”. ارتفع الهتاف: “نحفظ اليوم!”
“وأن نعطي الجزء الثالث من الشاقل لخدمة بيت إلهنا”. قالوا: “نقدم!”
“وأن نلتقط حطب الهيكل من حقولنا، ونقدم الباكورات من كل شجرة”. ردت الأصوات: “نفرح بالتقدمة!”
لم يكن الالتزام مجرد امتناع، بل كان إقراراً بالهوية. لقد قرروا، في ذلك اليوم، أن يكونوا شعباً مختلفاً، ليس منعزلاً، بل مميزاً بولاءه. كان العهد هو الجسر الذي يعبرون منه من ذل السبي إلى كرامة البنوة.
وعندما حَلّ المساء، وأُضيئت المصابيح، رُفعت اللفافة المليئة بالأسماء. نظر إليها الجميع، لا كمستند قانوني، بل كمرآة رأوا فيها وجوههم مجتمعة في صورة واحدة: صورة شعب يعاهد ربه. اختلطت رائحة الحبر الجاف برائحة البخور الخفيفة التي بدأت تتصاعد من الداخل، ورائحة عرق الكدح والأمل.
انصرف الناس إلى بيوتهم، ولكن خطواتهم كانت أثقل. ليس ثقل التعب، بل ثقل المسؤولية الحلوة. كانت أسماءهم مكتوبة الآن على جلد ماعز، ولكنهم شعروا، في قرارة أنفسهم، أنها نُقشت، بقلم من نار، على سفر القلب. وكانوا يعلمون أن الطريق طويل، وأن التجارب قادمة، ولكنهم، وللمرة الأولى منذ أجيال، عرفوا إلى أين هم سائرون، ومع من تعاهدوا على السير.