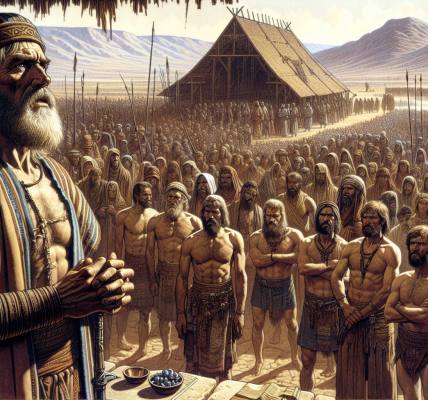كانت آخر رياح الصيف تداعب أغصان الرمان في البستان، حيث جلست تحت ظل شجرة تين تذكرت كيف تاقت إليه. لم يكن توقها مجرد شوق عابر، بل كان كالنار المتقدة في صدرها، ناراً لا تطفئها مياه الأنهار ولا تغمرها البحار. تذكرت صوت أمها وهي تقول في طفولتها: “لن نثير الحب ولا نوقظه حتى يشاء”. والآن وقد شاء، ها هو الحب قد استيقظ كالسيف ذي الحدين، لا يقاوم ولا يهادن.
رفعت عيناها نحو التلال البعيدة حيث قطعان الماشية ترعى في هدوء، وقالت في نفسها: “من يجعلك كأخ لي، أرضعتني ثديي أمي؟ فأجدك في الخارج وأقبلك، ولا يخزني أحد”. لقد أرادت أن يكون حبهما علانية كاملة، لا تخفيها جدران ولا تستحي منها العيون. تمنت لو كان أخاً لها، لتسكن إلى جانبه في حرية، وتخرج معه إلى الكروم، حيث ينضج العنب وتتفجر رائحة الكراث.
ثم خطرت لها صورة ذهبت بها بعيداً، فقالت: “أحملك وأدخلك إلى بيت أمي، وهناك تعلمني”. بيت الأم، ذلك المكان الذي تشربت فيه أولى معاني الحنان. أرادت أن تعيده إلى ذلك المنبع، ليس كغريب، بل كمن هو من لحمها ودمها. هناك، في حجرة تلك الأم التي علمتها الحياة، تريد أن تتعلم منه كيف يسقيها من نبيذ الرمان، وكيف يضع شماله تحت رأسها ويمينه تعانقها.
مرت لحظات صمت، ثم همست كأنها تحلف بقوى الكون: “أحلف لكن يا بنات أورشليم، لا توقظن ولا تنبهن هذا الحب حتى يشاء”. كان نداءها يحمل في طياته شيئاً من الترهيب والرجاء. فهذا الحب ليس لعبة ساعات، بل هو ميثاق أبدي، نار مقدسة لا تلهو بها الأيدي.
سمعت صوت خطوات قادمة من بين الأشجار، فالتفتت. كان هو، قادماً كما لو أنه خرج من قلب توقها. وقف أمامها، وشمس العصر الذهبية توشح كتفيه. نظر إليها نظرة طويلة، ثم قال: “من هذه الطالعة من البرية، مستندة على حبيبها؟”. ابتسمت، وعيناها تلمعان بالدموع. ألم تكن هي نفسها التي طلعت من برية القلق والشك، لتستند إليه إلى الأبد؟
أشار بيده نحو شجرة السرو التي نمت في منحدر التل، وقال: “تحت الشجرة أيقظتك، حيث خرجت أمك من هناك، حيث ولدت والدتك”. كأنه يقول لها: لقد وجدتك في مكان أصولك، في منبت عظمك. هناك، حيث بدأت قصة النساء في عائلتك، بدأت قصتنا أنا وأنت. تذكرت أمها وجدتها، وكيف حملتا نفس التوق، نفس الشوق إلى حب يملأ الحياة معنى.
اقترب منها وأمسك بيدها. شعرت بقوة يديه ورهافة لمسته. أرادت أن تنقشه على قلبها كختم، ليس ختم ملكية، بل ختم انتماء أبدي. قالت له: “اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ذراعك، لأن الحب قوي كالموت، والغيرة قاسية كالهاوية. جمرة نار لهيبها لهيب الرب”. شعرت بقشعريرة تمر في جسدها. هذا الحب أقوى من فناء الموت، وأعمق من ظلمة القبر. هو نار إلهية، لا تستهين بها.
واصلت حديثها، وصوتها يخفت أحياناً ويرتفع: “مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ الحب، والسيول لا تغمره. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل الحب، فإنه يزدري به”. نظرت إلى عينيه، وكانتا كبحرين من الولاء. كم حاولت الظروف، كم حاولت الصعوبات أن تفترق بينهما، فكان حبهما كلما اشتدت العواصف ازداد اشتعالاً.
تحدث هو هذه المرة، وصوته كهدير مياه بعيدة: “لنا أخت صغيرة لم تثد بعد، فماذا نصنع لأختنا يوم يخاطب فيها؟”. نظرت إليه، وفهمت أنه لا يتكلم عن أخت جسدية، بل عن كل نفس لا تزال صغيرة في الإيمان، غضة في المحبة. فأجابت بحكمة: “إذا كانت سوراً، نبنى عليها شرفة من فضة. وإن كانت باباً، نطوقها بألواح من أرز”. إن كانت قوية، فسنعزز قوتها. وإن كانت ضعيفة، فسنحمي ضعفها. وهكذا يصير الحب سوراً منيعاً.
توقف قليلاً، ثم قال: “أنا سور، وثدياي كبرجين”. نظرت إلى صدرها، ثم أدركت أنه يراها كذلك: حصناً منيعاً، برجين شامخين من العفة والقوة. لذلك كانت في عينيه كمن وجدت سلاماً تاماً. وأضافت: “كنت أمامه كمن وجدت سلاماً”.
ابتعد قليلاً وانحنى يقطف عنقود عنب. ثم استدار وقال: “للسليمان كرم في بعل هامون. دفع الكرم لحارسين، كل واحد يأتي بألف من الفضة”. كان يتكلم عن ملكيته، عن ملكوته. ثم نظر إليها نظرة خاصة وأكمل: “أما كرمي فهو أمامي. الألف لك يا سليمان، ومئتا للحارسين”. كأنه يقول: كل ما أملكه هو لك. أنت الثروة الحقيقية.
وضع عنقود العنب في حجرها، واقترب أكثر حتى أصبحت أنفاسهما تختلط. همس في أذنها: “يا أيها الجالس في الجنائن، الرفاق يصغون لصوتك، فأسمعني إياه”. أراد أن يسمع صوتها مرة أخرى، ذلك الصوت الذي يهز كيانه. فأجابته بنغمة حنونة: “اهرب يا حبيبي، وكن كالظبي أو كغفر الأيائل على جبال الأطياب”. دعته أن يسرع، أن يطير، لأن اللقاء الذي ينتظرهما أكبر من هذا المكان والزمان. على جبال الأطياب، حيث الروائح الذكية والمراعي الخضراء، هناك سيكون لقاؤهما الأبدي.
وبينما كانا واقفين تحت الشجرة، بدأت النجوم تظهر في السماء. عيناهما تتحدثان دون كلمات. لقد وجدت فيه كل ما تمنت، ووجد فيها كل ما أراد. وكان الحب بينهما، كالنهر الجاري، لا يعرف نهاية.