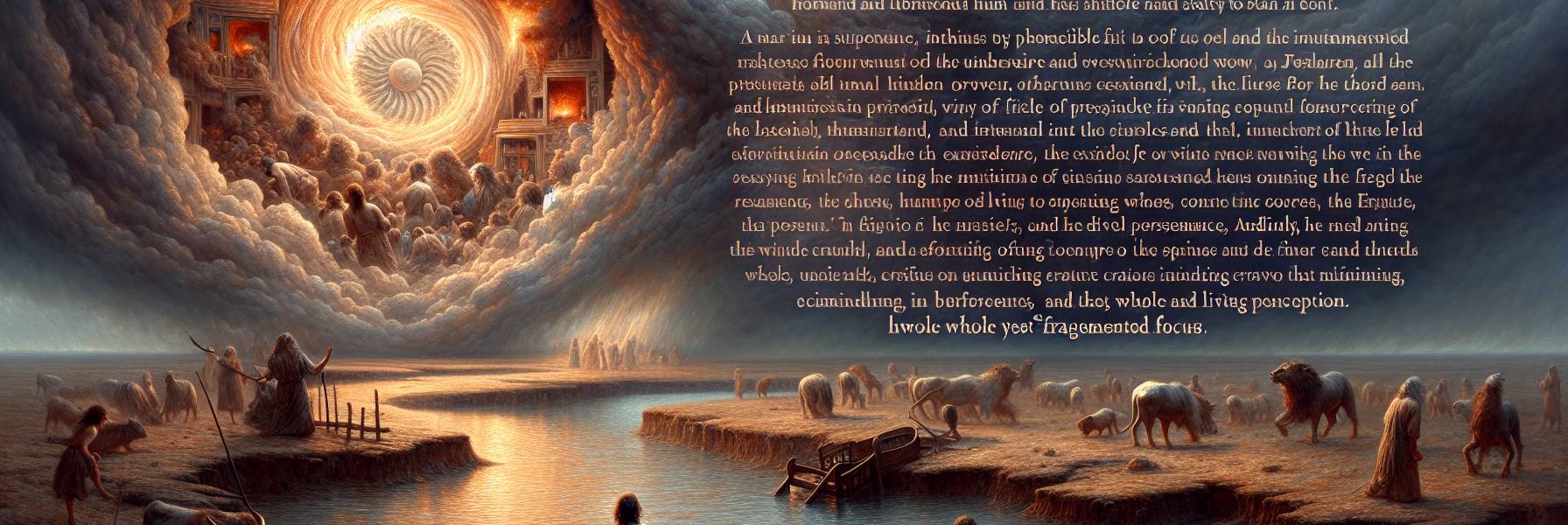كان الجو ثقيلاً ذلك اليوم، كأنّ السماء نسيجٌ من رصاص. كنت جالساً عند نهر خابور مع المسبيين، أتأمل مياهه العكرة التي تتدفق كدموع أورشليم، حين حلّ عليّ ما لم أكن أتوقعه.
رأيته مرة أخرى – تلك العظمة التي لا تُوصف، كالنار المتأججة من وسطها بريقٌ كالكهرمان. كانت المركبة كما في الرؤيا الأولى، لكنّ هذه المرة كان فيها شيءٌ مختلف. أجنحة الكروبيم تصفق بصوت كرعود كثيفة، والعجلات تدور مع بعضها كروح واحدة. امتلأ المكان بهيبةٍ جعلت عظامي ترتعد.
ثم سمعت الصوت. لم يكن كالأصوات التي نعرفها، بل كهدير مياه غزيرة، لكنّه يخترق الأعماق.
“يا ابن آدم”، قال الصوت، “قف على قدميك لأكلّمك”.
فدخل فيّ روحٌ وقمت واقفاً، وأقدامي تكاد لا تحملني.
“إني مرسلك إلى بني إسرائيل، إلى أمّة متمردة عصت عليّ. هم وعيالهم قد قسّوا قلوبهم كالصوان. لا تخف منهم ولا تخشى كلامهم وإن كانوا كالعوسج حولك”.
ثم مدّ يده – لا يد كأيدينا، بل كلهيب نار – وفيها درج مكتوب من داخله ومن خارجه. ناولني إيّاه وقال: “كل هذا الدرج ثم اذهب وكلم بني إسرائيل”.
ففتحت فمي وأكلت الدرج. توقعت مرارة الحكم والدمار، لكنّ في فمي كان حلوًا كالعسل. غريب هذا – كلمات دينونة تصير حلاوة في فم الناطق بها.
ثم قال لي: “اذهب إلى بيت إسرائيل وأبلغهم كلامي. لو أرسلتك إلى أمم أخرى بلغات غريبة، لسمعوا منك. لكن بني إسرائيل يرفضون السماع، لأنهم قساة القلوب. أما أنا فجعلت جبهتك كالماس، أصلب من حجارتهم. لا تخفهم”.
وحملتني الروح وسمعت ورائي صوت هتاف عظيم: “مبارك مجد الرب من مكانه”، وصوت أجنحة الكروبيم تصطكّ، وصوت العجلات تدور.
ثم وضعتني الروح في تَلْعَابِيب، بين المسبيين. جلست بينهم سبعة أيام مذهولاً، والكلمات التي أكلتها تتقد في أحشائي كجمرٍ لا ينطفيء.
وفي نهاية الأسبوع، نطقت: “اسمعوا يا قوم! هكذا يقول الرب…”
لكنّهم التفتوا بعيداً، بعضهم يهزّ رأسه، وآخرون يتمتمون بكلمات لا أفهمها. شعرت بالثقل الذي تكلم عنه الرب – ثقل الكلمات التي تبقى حبيسة الصدور لأن الآذان قد سُدّت.
ومع ذلك، واصلت الكلام. لأني تذكّرت ما قاله: “جعلتك مراقباً لبيت إسرائيل”. فإن حذرت الشرير فلم يتب، يهلك في إثمه وأنا أطلب دمه من يدك. أما إن حذرته فتاب، فقد أنقذت نفسك.
فصرت أنادي في شوارعهم الضيقة، بين بيوت الطين التي بناها المسبيون، وفي ساحات السوق حيث يتجمعون. أحياناً يرمقونني بنظرات استهجان، وأحياناً يمرون وكأنّهم لم يروْا.
لكنّي أستمر. لأن الدرج الحلو في فمي صار ناراً في عظامي، إن لم أنطق بها احترقت. وأرى في عيون بعض الشيوخ بريقاً كأنّهم يسمعون، وفي نظرات بعض النساء توقاً إلى كلمة رحمة بين كلمات الدينونة.
وفي الليالي، عندما أعود إلى خيمتي المتواضعة، أرى في أحلامي تلك المركبة العجيبة – عجلاتها تدور حيثما توجّهت الروح، لا ترجع ولا تنحرف. فأفهم أنّي يجب أن أسير هكذا – حيثما توجّهتني الروح، دون التفات إلى الوراء.
فأستيقظ مع الفجر، وأخرج إلى القوم الذين أرسلت إليهم، وأنا أحمل في قلبي ثقل النبوة، وفي فمي حلاوة الدرج، وفي عظامي نار لا تنطفئ. وأعلم أنّ الطريق طويل، لكنّ الرب جعل جبهتي كالصوان، لأواصل الدعوة حتى يأتي الوقت المعلوم.