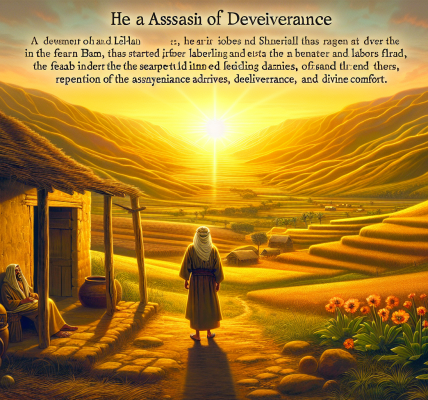كانت الريح تعوي فوق التلال الجرداء، حاملةً معها ذكريات أيامٍ لم تبقَ منها إلا صورٌ شاحبة في أذهان الشعب. جلست تحت شجرة بطمٍ عتيقة، جذورها تشقّق الأرض كما تشقّق الخطيئةُ قلوبَ البشر. كنت أحد الباقين، ممن لم تُغوِهم أصنامُ العمّوريين ولا قرابينُ البعل. كان الإله الحقيقي، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يصبح في تلك الأيام مجرد صوت خافت بين زئير الآلهة الوثنية، وكأنه نبع ماء عذب غارق في ضجيج بحر مالح.
وفي إحدى تلك الليالي، حين كان القمر محاقاً والظلام دامساً كقلب فرعون، هبت ريح مختلفة. لم تكن حارةً كريح الشرق ولا باردةً كريح الشمال، بل كانت كنسيمٍ يحمل رائحة أرض بعيدة، أرض موعودة. وسمعت، لا بأذنيّ بل بما هو أعمق فيّ، صوتاً يهزّ كيان الوجود: “اسكتوا إليّ يا جزر، ولتجدّد القبائل قوة. ليقتربوا ثم يتكلموا. لنتقدم معاً للقضاء.”
ارتعدت فرائصي. كان كلاماً يخاطب الأمم، لكنه اخترق ظلام روحي الشخصي. تذكرت أبي وهو يحكي عن سيناء، كيف كان الكلام الإلهي يزلزل الجبال. وها هو الآن، في هدوء الليل المر، يزلزل جبال اليأس التي ركمتها في صدري.
ثم اتسعت الرؤيا، كستائر الهيكل التي تمزقت. رأيت، ليس بالبصر ولكن ببصيرة الروح، رجلاً من الشرق، عبداً اختاره الرب من بين الأمم. كان يخطو فوق الممالك كأنها تراب تحت قدميه، يدوس الملوك والصولجان والعروش، ويجعل سيفه غباراً تذروه الرياح. كان اسمه كورش، لكننا لم نكن نعرفه بعد. كان مجرد ظلٍ آتٍ من مشرق الشمس، أُعدّ كأداة في يد الصانع القدير. وفهمت فجأة أن الإله ليس إلهاً لقبيلة صغيرة وحسب، بل هو خالق السموات والأرض، والقابض على أزمة تاريخ الأمم، يحرك الملوك كما يحرك الراعي قطيعه.
صاح الصوت مرة أخرى، لكن هذه المرة كان الخطاب مباشراً، حميماً وكاسراً: “أما أنت يا إسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، يا نسل إبراهيم حبيبي.” دمعت عيناي. بعد كل هذا الزني الروحي، بعد كل هذا العبث بعبادة الأصنام، يصرّ الرب على تسميتنا “عبده”. لم يكن ذلك استحقاقاً منّا، بل اختياراً من محض النعمة. “خذتك من أقصى الأرض، ومن أطرافها دعوتك. وقلت لك: أنت عبدي، اخترتك ولم أرفضك.”
شعرت بقشعريرة تسري في جسدي. كلمات النعمة هذه كانت أقسى على نفسي من توبيخ. هو يختارنا، نحن الضالّين، نحن الذين باعوا البكورية طبقاً من عدس. “لا تخف لأني معك. لا تتلفت لأني إلهك. قد شددتك وأعنتك، وعضدتك بيمين بري.” كانت اليمين، رمز القوة والقسم. وهو يقسم ببره، لا ببرنا نحن، أن يمسك بنا.
ثم رأيت، كمن يشهد مشهداً نُقش على حائط الزمن، ما سيأتي. ستقوم أمم غريبة وتتحالف، كالكلاب الضالة التي تجتمع على فريسة. سيصنعون أصناماً من خشب وخيرزان، يشدّدونها بالمسامير كي لا تتزعزع. وستكون سخافة عظيمة. كيف يعبد الإنسان ما صنعت يداه؟ كيف يخضع لمخلوقٍ من صنع مخيلته؟ بينما الإله الحقيقي، هو الذي خلقنا، وهو الذي يحملنا من الأحشاء حتى الشيخوخة. قالها بوضوح: “هوذا هم كلا شيء. صنعهم ريح وخراب.”
تحولت الرؤيا إلى وعد ملموس. “الفقراء والمساكين يطلبون ماء ولا يوجد. لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أجيبهم، إله إسرائيل لا أتخلّى عنهم.” تذكرت مسير الآباء في البرية، وكيف تفجّر الحجر ماءً. كان الرب هو النبع نفسه. وهو نفسه وعد أن يفجّر في القفار أنهاراً، ويجعل الأرض اليابسة ينابيع ماء. ليس ماءً فقط، بل غابات من أشجار الأرز والسرو والزيتون، لتكون شهادة للجميع أن يد الرب قد صنعت هذا.
وفي ذروة هذا الوعد، جاءت الدعوة التي تلمس صميم الوجود البشري: “ليرفعوا ويأتوا ويقرّبوا قضيتهم معاً.” كان الرب يدعو الأمم كلها إلى محكمة سماوية، ليبرهن لهم من هو الإله الحق. “من أخبر بهذا من البدء منذ القديم؟ أليس أنا الرب؟ وليس آخر إله غيري. إله بار ومخلص. ليس سواي.”
انكشفت الغيمة. لم يعد الإله فكرة مجردة أو قوة بعيدة. كان هو الأول والآخر. البداية والنهاية. من يمسك بيد الضال في ظلام تاريخه، ويقوده إلى نور. من يجعل القفر بستاناً، واليأس رجاءً.
عند الفجر، حين بدأت حافة الشمس تلمع من وراء جبال موآب، لم أعد ذلك الجالس تحت شجرة البطم. نهضت، وكأنني خرجت من قبر طويل. الرياح التي كانت تعوي بالأمس، سمعتها الآن كترنيمة بعيدة. كان الخوف قد ذاب مثل جليدٍ على موقد. لم يكن الخلاص مجرد فكرة، بل كان شخصاً. وكان ذلك الشخص، الإله القدير، يقول لي، ويقول لشعبٍ مشرّد في قلبه قبل أن يُشرّد من أرضه: “لا تخف. أنا معك.”
في ذلك الصباح، كتبت كل ما سمعت ورأيت على درفتين من الخشب. وعندما سألني الناس عن سبب النور الذي في عينيّ، لم أستطع إلا أن أردد بصوت مختنق بالفرح والرهبة: “إن الرب يقيم من الشرق رجلاً، ويقيم من الظلام نوراً. وهو يقول للقلقان: تشدد.” كانت البداية فقط. وكان الطريق طويلاً. ولكن اليد التي صورت النجوم وحددت مسارها، كانت قد مدت يمنى البر لتشدد يد عبدٍ ضعيف، وسط صحراء العالم.