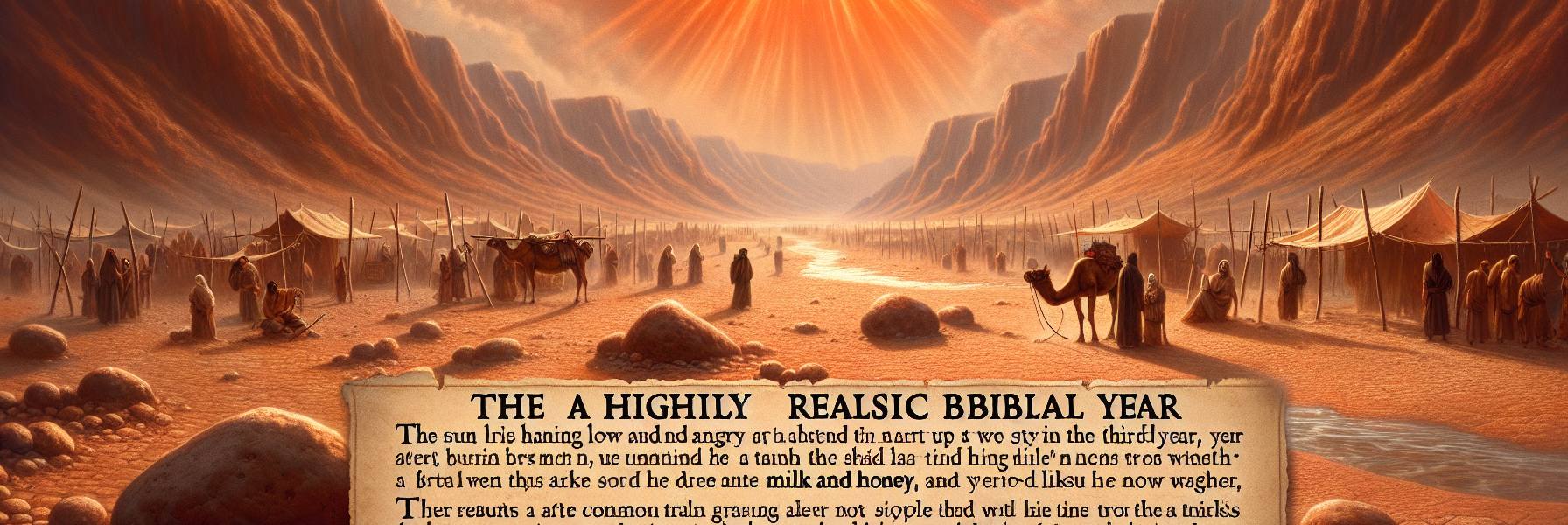كانت الشمس تميل نحو الغرب، تلقي بظلال طويلة على تخوم الجبل. جلست شيخا تحت شجرة بطم معمرة، تلمع عيناها في وجه محفور بتجارب السنين. حوله اجتمع شباب القرية، وجوههم مشرقة بفضول من لم تختبر الحياة بعد. كان يتنفس بصعوبة، كما لو أن كل كلمة سيخرجها من صدره تحمل ثقلا من الذكريات.
“اسمعوا لي،” بدأ صوته خافتا ثم اشتد. “لقد عشت طويلا، ورأيت الكثير. لقد رأيت كيف يمكن للقلب أن ينخدع، وكيف يمكن للشيء الحلو أن يخفي سما قاتلا.”
توقف ليشرب جرعة ماء من جرّة فخارية بجانبه. أحد الشباب، اسمه ألياف، كان يجلس في المقدمة، عيناه لا تفارقان وجه الشيخ.
“تذكروا ما حدث في قرية ناحوم، إلى الشمال من هنا،” استأنف الشيخ. “كان هناك رجل، اسمه باروخ، كان صديق طفولتي. كان ذكيا، طيب القلب، يحسن الحديث ويجيد الإقناع. ثم، بعد رحلة تجارية إلى البلاد المجاورة، عاد مختلفا. بدأ يتحدث عن طرق جديدة، عن آلهة رأى الناس يعبدونها هناك، آلهة تمنح الغنى السريع وتحقق كل رغبة. كان يتكلم بلهفة، وكانت كلماته كالعسل.”
حرك الشيخ جسده وكأنه يتألم من ذكرى قديمة. “بدأ الناس يستمعون إليه، خاصة الشباب الذين ملوا من صرامة الشريعة، من انتظار البركات التي تأتي بعد جهد وصبر. قال باروخ: ‘لماذا ننتظر؟ هذه الآلهة تعطي الآن. انظروا إلى أراضي أولئك الشعوب، كيف هي خصبة! انظروا إلى ثرواتهم!’ كانت كلماته مثل نار تأكل في الحطب الجاف.”
ساد صمت، لا يقطعها سوى حفيف أوراق الشجرة ونقيق حشرة بعيدة. كان ألياف يتنفس بصوت مسموع.
“حتى أن باروخ،” تابع الشيخ بصوت أجش، “ادعى ذات يوم أنه رأى حلما، وأن ملاكا ظهر له يأمره باتباع تلك الطريق الجديدة. قال: ‘لا يكون الرب قد غضب علينا فحرمنا الخير في هذه الأرض القاسية؟ ربما يريدنا أن نبحث عنه بهذه الصورة الجديدة.’ آه… لقد كان مخادعا بارعا. حتى أن بعض العائلات المحترمة بدأت تتزعزع. زوجته، التي كانت تقية، حاولت أن ترده، فطردها. أمه، العجوز الطيبة، بكت أمام باب بيته فلم يفتح.”
رفع الشيخ إصبعه الملتوي بفعل الزمن. “وهنا تكمن الفخ. الفخ ليس في العدو الذي تعرفه، بل في الصديق الذي تحبه. ليس في الغريب الذي يأتي من بعيد، بل في الأخ الذي نام إلى جوارك في الخيمة ذاتها. عندما يأتي الإغراء من الداخل، من بيننا، يكون الاختبار أقسى. ولكنه أيضا الأجدر بأن نثبت فيه.”
سأل ألياف، متحمسا: “وماذا حدث يا شيخنا؟ كيف عرفتم أنه على ضلال؟”
ابتسم الشيخ ابتسامة حزينة. “لأن الكلام، يا ابني، يطير كالريش. لكن الثمر يبقى على الأرض. بدأ باروخ يطلب القرابين سرا، ليس من أغنامنا فحسب، بل من أثمن ما نملك. بدأ يزرع الشقاق بين الأخ وأخيه، بين الابن وأبيه. كان يعد بالذهب، لكنه كان يسرق السلام. تذكرنا كلام موسى عليه السلام: ‘حتى وإن جاءت الآية والعجوبة، ولكن دعاك إلى اتباع آلهة أخرى لم تعرفها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي.’ فالعلامة الحقيقية ليست في قدرته على صنع العجيب، بل في اتجاه الدعوة. هل تدعو إلى الرب، أم تدعو إلى نفسها وإلى آلهة الهوى والشهوة؟”
“وكانت النهاية؟” همس شاب آخر.
“النهاية…” تأمل الشيخ طويلا. “لقد اجتمع شيوخ القبائل. وبعد مشقة كبيرة، وبعد ليال من الصلاة والدموع، فعلوا ما أمرت به الشريعة. كان يوما مظلما. كان علينا أن نطهر الشر من بيننا، ولو كان الثمن أن نفقده هو. لأن محبة الرب، والتي هي أساس الحياة، لا تتساوم. السم القليل يفسد الوعاء كله. الصدأ الصغير يأكل في السيف كله.”
سقطت قطرة عرق من جبين الشيخ، اختلطت بدمعة خفية عند زاوية عينه. “لا تظنوا أن القلوب كانت قاسية. بل كانت ممزقة. ولكن الخيار كان بين وفاء الفرد وبين حماية الجماعة. بين عاطفة مؤقتة وبين عهد أبدي. لقد اختار باروخ طريقه بملء إرادته، بعد أن نُصح ووُعظ. كانت رحمة الله في إنذاره لنا، لئلا ننجرف جميعا في الهلاك.”
بدأت نسمة باردة تهب مع اقتراب الليل. “لهذا، يا أبنائي،” قال الشيخ وهو ينهض ببطء، متكئا على عصاه، “اغرسوا كلام الرب في قلوبكم بعمق. تعلموه في بيوتكم، وتحدثوا به حين تقومون وحين تضطجعون. لأنه عندما يكون القلب مملوءا بالنور، لا مكان للظلمة. وعندما يكون الحب للرب راسخا كالجبل، لا تهزه رياح الإغراء. كونوا حكماء كالحيات، وبسطاء كالحمام. والرب وحده يكون سندكم.”
وتحت ظلام السماء المرصع بالنجوم الأولى، عاد كل شاب إلى بيته، يحمل في صدره سؤالا ثقيلا، وصورة لوجهين: وجه باروخ المخادع، ووجه الشيخ الحكيم الذي فضل الحق على الراحة، والجماعة على الفرد، والعهد على الهوى. وكان الدرس الأعمق أن الإيمان ليس مجرد طقوس، بل هو اختبار يومي للإخلاص، في صمت القلب قبل علانية اللسان.