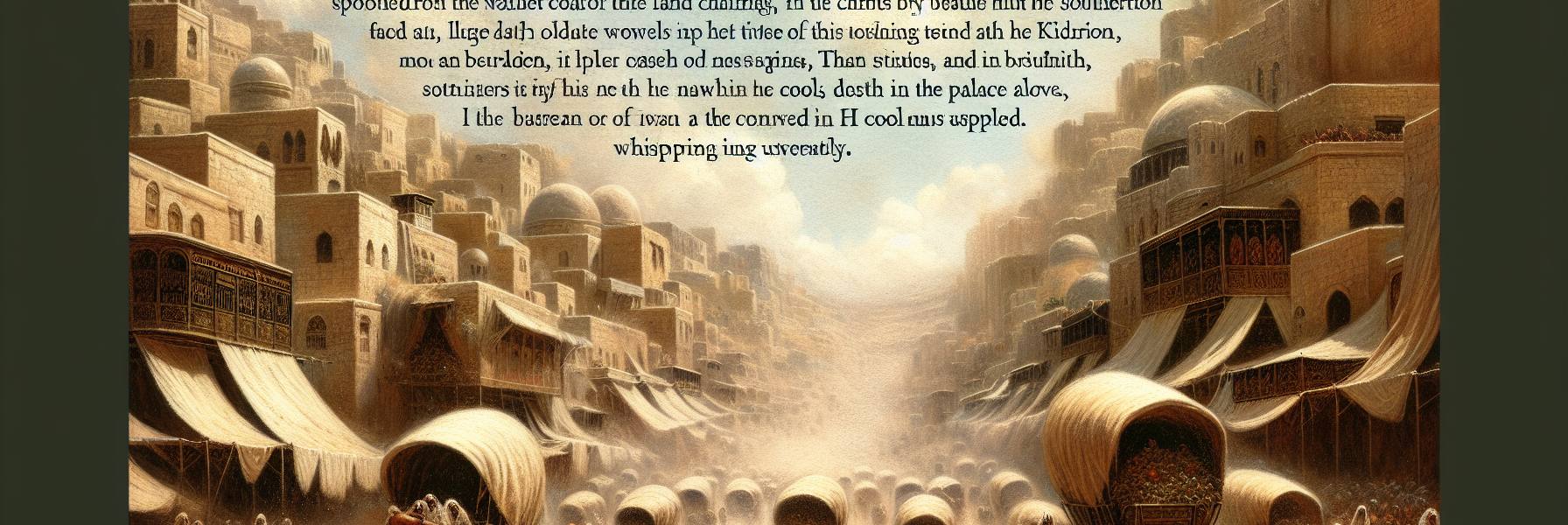كانت أورشليم في تلك الأيام كجرة تين هزيلة، أغصانها متشابكة تحمل ثمارًا مرة. جاء الخبر كريح شرقية حارقة: جيوش آشور تتقدم، كالسيل الذي لا يُرد، تحمل في قلوبها طمعًا وفي أيديها حديدًا. وفي القصر، حيث رائحة الأرز تفوح من العواريس، اجتمع رجال يهوذا حول الملك.
كان صوت الحكيم يشعيا يعلو، أحيانًا، كنداء بعيد، ثم يخفت تحت ثقل القرارات. لكن آذان كثيرة كانت قد سددت بقطران الكبرياء. قال أحد القادة، ويده على مقبض سيفه: “سنرسل رسلًا إلى مصر. سندفع ذهبًا كثيرًا. فرعون قوي، ومركباته لا تُحصى. سيحمي ظهورنا.” وكانت كلماته ثقيلة وواثقة، كحجارة السد.
خرج يشعيا من تلك الجلسة، وكأنه يحمل جبلًا على كتفيه. مشى في الأزقة الضيقة، حيث رائحة الخبز تختلط برائحة الخوف. نظر إلى الأسوار العالية، التي بناها أباطرة، وإلى الأبراج التي تلامس السحاب. رأى في عينيه ليس الحجارة، بل وهما عظيماً. فهي لن تصمد أمام من يأتي باسم الرب نفسه لتأديب شعبه.
جلس في حجرته المتواضعة، قرب باب الضيق. أمامه رقعة من جلد ماعز، ودواة بالية. ولكن ما كان يكتبه لم يكن مجرد كلمات. كان صرخة. كانت نبوءة تنز دماءً حقيقية. كتب:
“وَيل للذين ينزلون إلى مصر للمعونة، ويستندون على الخيل، ويتكلون على مركبات لأنها كثيرة، وعلى فرسان لأنهم أقوياء جدًا، ولكنهم لا ينظرون إلى قدوس إسرائيل، ولا يطلبون الرب.”
توقف قلمه. سمع خارج النافذة صوت حداد يطرق الحديد، يصنع سيفًا جديدًا ليحمي تاجرًا غنياً. ضربة المطرقة كانت إيقاع ذلك الزمن: قاسية، منتظمة، بلا روح. تذكر كيف كان الرب، في سالف الأيام، يغيثهم. كيف شق البحر كرداء، وكيف أسقط أسوار أريحا بدون حمل رمح واحد. الآن، صاروا كطفل يهجر حضن أمه ليستند إلى غصن شائك.
ثم جاءت الصورة إلى قلبه، قوية كالرعد: “فالرب كالأسد يزأر، وكالشبل يصرخ على فريسته. يحوم ويحلق كالطيور على بيتها.” رأى تشبيهين. الأول: أسد لا يرحم، لا تفاوض معه، لا تهدئه ذهب ولا وعود. الرب نفسه سيخرج على متكبري آشور، ليس كحليف، بل كقاضٍ غاضب. والثاني: طائر يحوم بجناحيه، يحمي عشه. هو نفسه الذي سيكون حصنًا لِمن يبقى في أورشليم، ويثق به حقًا. يا للغرابة! هو الأسد والطائر في آن. هو الديّان والحامي. الفرق ليس فيه، بل في قلوب شعبه.
كتب المزيد: “فيرجع كل رجل إلى معبوده من الفضة، وإلى تماثيله من الذهب.” رأى تلك التماثيل الصغيرة، المصنوعة بأيد بشرية، مخبأة في البيوت. في ساعة الخطر، سيلجأون إليها، وهي لا تنطق ولا تتحرك. سيسجدون لما صنعوه هم أنفسهم. وكانت هذه هي الذروة في سخرية المأساة: الإنسان يسجد لقوة وهمية من صنعه، ويتجاهل القوة الحقيقية التي صنعته.
أخيرًا، كتب الوعد، الوعد الذي يلمع كجمرة تحت الرماد: “يقول الرب: الذي يخدمني سيسقط بسيف، ولكن ليس سيف بشر. وسيفي ليس كسيف بشر. بل يفر آشور بالسيف، لا سيف رجل.”
لم يكن هذا وعدًا بنصر عسكري تقليدي. كان وعدًا بخلق واقع جديد. ستسقط آشور، ولكن ليس بقوة مصر ولا بحيلة يهوذا. ستسقط لأن الرب سينزل في قلوب قادتها روح الرعب، وستتحول قوتهم إلى فوضى. ستكون النهاية كحلم استيقظ منه الجميع ليجدوه سرابًا.
طوى يشعيا الرقعة، ووضعها جانبا. خارج النافذة، بدأت الشمس تغرب، تلون أسوار المدينة بلون الدم. كان يعرف أن قادة الشعب سيسيرون في طريقهم المصري، حاملين الهدايا والعباءات الفاخرة، واثقين من الحصان والمركبة. وكان يعرف أن الكثيرين سيهلكون في هذا الطريق. لكنه كان يعرف أيضًا أن نار الرب ستحمي تلك النواة الصغيرة، تلك البقية التي تتعلم، في الظلام، أن ترى النور الوحيد الذي لا ينطفئ.
في صمت الغرفة، بدا وكأنه يسمع صوتين: صوت حداد الحديد المتواصل، وصوت زئير أسد بعيد. ومضت أيام كثيرة قبل أن تتحقق الكلمة، وتصير جمرة الوعد نارًا تأكل الغرور كله، وتترك، وسط الرماد، بذرة جديدة لشعب أكثر حكمة.