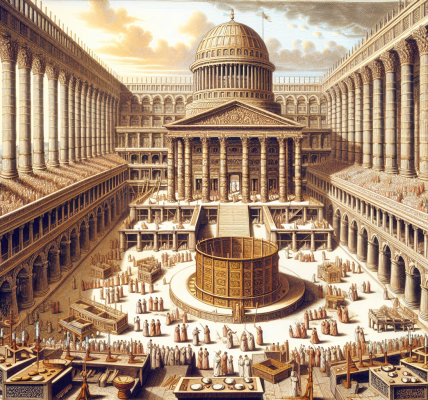في البدء، قبل أن تكون سماء تُزرقّ، وقبل أن تنشقّ الأرض عن جبالها وأنهارها، كانت الكلمة. ليست حرفاً يُكتب، ولا صوتاً يُلفظ، بل كيانٌ حيّ، شاهدٌ منذ الأزل، مقيمٌ في حضرة الله ذاته. كانت الكلمة مع الله، وكانت الكلمة الله. منها انبثقت الحياة، وفيها كان النور الذي للبشر، نورٌ حقيقيّ يضيء في قلب الظلام، وظلمة العالم كلّه لم تُدركه.
أرسل الله رجلاً، اسمه يوحنا، من البرّية القاحلة حيث صمت الأرض يصرخ. جاء شاهداً، لا ليكون هو النور، بل لينادي به، ليهيئ الطرق، ليرفع منخفضات القلوب، وليسدّ هَوَات اليأس بين التلال. كانت صيحته في البرية كصوت غريب، مجلجلة، تعلن عن مجيء الآتي، الذي كان موجوداً قبله، رغم أنه سيأتي بعده. لأن النور الأزليّ لا يُقاس بزمن.
ثم حدث، في ملء الأيام، أن الكلمة التي كانت عند الله، خرجت من حِجْب الأزل لتلبس جسداً من لحم ودم. نزلت إلى عالمها، إلى أرض صنعتها يداها، فسكنت بين ظهرانينا. رأينا مجدها، مجداً فريداً، كمجد الابن الوحيد الآتي من الآب، ممتلئاً نعمةً وحقاً.
لكن العالم الذي صنعته لم يعرفها. وشعبها الخاص، الذين أعدّت لهم ناموساً وأنبياء، رفضوا أن يقبلوها. ولكن كل من قبلها، كل من آمن باسمها، أولئك وهبتهم سلطاناً عجيباً: سلطان أن يصيروا أبناء الله. لم يولدوا من دم متحرك، ولا من رغبة جسد، ولا من إرادة رجل عابر، بل وُلدوا من الله ذاته.
وأخذت الكلمة المتجسدة تُخيّم بيننا. لقد رأيناها بأعيننا، ولمستها أيدينا. مجدٌ ساطع، كمجد الآب، لكنّه محفور في خطواتٍ متعبة على تراب فلسطين. نعمة فوق نعمة، تفيض من ملئها. الناموس أُعطي بموسى، أما النعمة والحق فقد أتيا بها، بيسوع المسيح. لم يرَ أحدٌ الله قط في أي زمان، لكن الابن الوحيد، الذي هو في حضن الآب منذ البدء، هو قد أخبرنا عنه، كشف لنا سرّ محبته.
وذات يوم، بينما كان يوحنا المعمدان يشهد بين الجموع، أقبلت إليه هيئة رجال من أورشليم، كهنة ولاويون، يسألونه: “من أنت؟” فاعترف ولم ينكر، بل صرّح: “لست أنا المسيا”. فسألوه: “أإيليا أنت؟” قال: “لستُ”. “أالنبي أنت؟” فأجاب: “لا”. فاحتدّوا في السؤال: “من أنت؟ لنرد جواباً إلى الذين أرسلونا. ماذا تقول عن نفسك؟” فقال يوحنا بصوته الخشن، المليء باليقين والوداعة: “أنا صوت صارخ في البرية: قوّموا طريق الرب، كما قال إشعياء النبي”.
وكان بين السائلين مَن أُرسلوا من الفريسيين. فسألوه: “فلماذا تعمّد إذا لم تكن المسيح، ولا إيليا، ولا النبي؟” فأجابهم يوحنا: “أنا أعمّد بماء. ولكن في وسطكم قائمٌ من لا تعرفونه. هو الذي يأتي بعدي، الذي صار قُدّامي، الذي لستُ أنا بمستحق أن أحلّ سيور حذائه”. قال هذا في موضع عبر الأردن، حيث كان الكثيرون يأتون ليعتمدوا ويعترفوا بخطاياهم. كانت مياه النهر تلمع تحت الشمس، وكأنها تترقب شيئاً عظيماً.
وفي الغد، رأى يوحنا يسوع مقبلاً إليه. لم يكن قد رآه هكذا من قبل، لكن نوراً في قلبه، وإعلاناً من السماء، جعله يعرف. فرفع إصبعه، وصاح في الحاضرين، صيحة تخلخل الهواء الهادئ: “هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم! هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي. وأنا لم أكن أعرفه. لكن لكي يُعرَّف لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء”.
وصف يوحنا ما حدث: “رأيت الروح نازلاً مثل حمامة من السماء، فاستقر عليه. وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء، قال لي: الذي ترى الروح نازلاً ومستقراً عليه، فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله”. كان الصوت يرتجف قليلاً، ليس من خوف، بل من بهاء ما رأى.
وفي اليوم التالي، كان يوحنا واقفاً مع اثنين من تلاميذه، وكان يسوع يمشي قريباً. فتطلع يوحنا إليه مرة أخرى، بعينين ممتلئتين إجلالاً، وقال: “هوذا حمل الله!” فسمع التلميذان هذه الكلمات، وتركا معلّمهما، وتبعا يسوع. شعرا بجاذبية لا تقاوم، كنهر يتدفق إلى مصبه. والتفت يسوع، ورأيهما يتبعانه، فقال لهما: “ماذا تطلبان؟” قالا له: “ربي…” – وكانت الكلمة تختلج في حناجرهما – “أين تمكث؟” فقال لهما: “تعاليا وانظرا”. فذهبا ورأيا أين يمكث، ومكثا عنده ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو العاشرة.
وكان اسم أحد هذين التلميذين، الذي سمعا يوحنا وتبعا، أندراوس أخا سمعان بطرس. فذهب هذا أندراوس، مسرعاً، شاعراً أن أعظم كنز في الحياة قد وجده، فبحث عن أخيه سمعان، وقال له: “قد وجدنا مسيّا!” وجاء به إلى يسوع. فنظر إليه يسوع وقال: “أنت سمعان بن يونا. أنت تُدعى صفا” – الذي تفسيره: بطرس – “. كأنه كان يرى في عمق الصياد الخشن صخرة مستقبلية.
وفي الغد، أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل. فوجد فيلبس، فقال له: “اتبعني”. وكان فيلبس من بيت صيدا، من مدينة أندراوس وبطرس. فراح فيلبس بدوره يبحث عن صديقه، نثنائيل، وكان يجلس تحت شجرة تين، ربما يقرأ أو يتأمل. فقال له: “وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء: يسوع ابن يوسف، الذي من الناصرة!” فتجهم نثنائيل وقال، بكلمات مشككة تعكس واقعية رجل يعرف البلدة الصغيرة: “أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟” قال له فيلبس، مبتسماً، مدركاً أن الكلمات لا تكفي: “تعال وانظر”.
ولما رأى يسوع نثنائيل مقبلاً إليه، قال عنه: “هوذا إسرائيلي حقاً، لا غش فيه”. فسأله نثنائيل، مندهشاً: “من أين تعرفني؟” أجاب يسوع وقال له: “قبل أن دعاك فيلبس، وأنت تحت شجرة التين، رأيتك”. فانفتحت عينا نثنائيل، واهتزت كل شكوكه كأوراق الخريف، وانحنى وقال: “ربي، أنت ابن الله! أنت ملك إسرائيل!” فأجابه يسوع: “هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت شجرة التين؟ سوف ترى أعظم من هذا”. ثم قال له كلمات غامضة، جميلة، كفتح نافذة على أبدية واسعة: “الحق الحق أقول لكم: من الآن ترون السماء مفتوحة، وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان”.
وهكذا، في تلك الأيام الأولى، بدأ النور يشرق في الظلمة. كلمة الأزل، صارت كلمة على شفاه بشرية، تلمس أكتاف صيادين، وتنظر إلى قلب إسرائيلي حق، وتبعث في النفوس رجاء لم تعرفه من قبل. الحياة كانت فيه، والنور كان فيه، والمجد الحقيقي، مختبئاً في ثنايا الطرق الترابية في الجليل، بدأ رحلته.