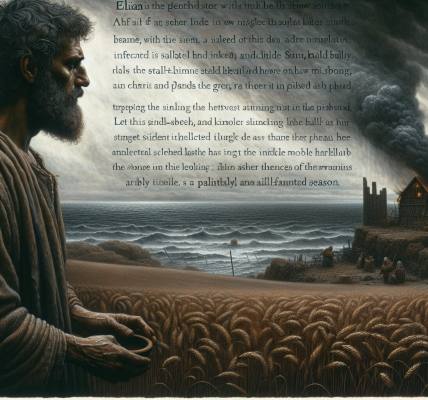كان الصباح يتنفس بخفة على تخوم البرية، وكان الهواء لا يزال يحمل لسعة الليل البارد. وقف أليآف، الكاهن الشاب، عند مدخل خيمة الاجتماع، وهو يشاهد أول خيوط الشمس الذهبية تلمس قمم الجبال البعيدة. في يديه، إناء من فخار بسيط، مملوء حتى حافته بدقيق ناعم، مخلوط بزيت، وكأس من خمر. كانت رائحة الطحين والزيت ترتفع منه، رائحة بسيطة، واعدة، كأنها نذير بشيء مقدس على وشك الحدوث.
داخل الدار، كان الجو هادئاً، مهيباً. لم تكن الخيمة مجرد أقمشة وجلود، بل كانت قلباً ينبض للجماعة كلها. وكانت شعائر الصباح والمساء، كما عرف أليآف من شيخه الكاهن، هي نفس هذا القلب، نبضاته المنتظمة التي لا تتوقف. نَفَسُ الجماعة نحو الرب.
تقدم نحو المذبح النحاسي. كان الحطب مُرَتَّباً بدقة، ينتظر الشرارة. قبل أن يبدأ، أغمض عينيه للحظة. تذكر كلمات موسى، التي نُقِلت إليهم جميعاً، كلمات الرب في البرية: “احْرِصُوا أَنْ تُقَدِّمُوا لِي فِي وَقْتِهَا قُرْبَانِي، طَعَامِي”. لم تكن كلمة “طعامي” مجازاً بسيطاً، بل كانت حقيقةً غامضةً تملأ القلب رهبة. الله، خالق السموات والأرض، يشاء أن تكون له مائدة، وأن تكون له أوقاتٌ محددة، دقيقة، لا تُخلف.
أشعل النار. ارتفعت ألسنة اللهب برقّة في البداية، ثم استوت. أخذ حملًا، ذكراً، حولي السنة، لا عيب فيه. شعر بدفء جسده تحت يديه، وبطمأنينة الحيوان الذي لا يدري. وضع يده على رأسه بلطف، ثم ذبحه بسرعة وحِدَّة، كما تعلّم. سال الدم، دافئاً وقانياً، على قاعدة المذبح. كان الدم هو الحياة، وكان سكبه هو العودة، هو الجسر. ثم شرع في التقدمة. ذَبَحَ الحَمَلَ، ورشَّ الكاهنُ دمَه على المذبح مُستديراً. نَزَعَ شَحْمَهُ وَكُلْيَتَيْهِ، وَالكُسْبَةَ الَّتِي عَلَى كَبِدِهِ، وَأوقَدَهَا عَلَى المَذْبَحِ. كانت رائحة الشحم المحترق، الممزوجة بدخان الحطب، رائحة ثقيلة، حلوة وغريبة في آن. “رَائِحَةُ سَرُورٍ لِلرَّبِّ”. كرر العبارة في سره. كانت كل حركة محسوبة: عشر الأف للدقيق مع ربع الهين من الزيت المغلوط. خبزت التقدمة. وكان السكب: ربع الهين من الخمر لكل حمل. الخمر، علامة الفرح، تُسكب كسكيب للرب.
كان هذا هو المحرقة الدائمة. الصباح والمساء، كل يوم، كالفجر والغسق، كالتنفس والزفير. كان في رتابتها عُمق لا يدركه إلا من يمارسها. فهي تذكير بأن القداسة لي حدثاً استثنائياً، بل إيقاع حياة. وأن حضور الرب لا ينتظر مناسبات عظيمة، بل هو هنا، الآن، في لهيب هذا المذبح الصباحي، يلتقي بشعبه.
مرت الأيام. وتعلّم أليآف أن الأسبوع له نَغَمَةٌ مختلفة. ففي اليوم السابع، يوم السبت، يتضاعف النَفَس. يُقدَّم حملان حوليا السنة، بدلاً من حمل واحد، مع تقدمة الدقيق والسكيب المزدوجة. كان السبت توقفاً، ذكرى للخلاص والراحة، ولكنه في الخيمة لم يكن توقفاً عن العبادة، بل ازدياداً فيها. ازدياد في القرابين، ازدياد في الفرح. كان يوم اكتمال، يوم وفرة في العطاء للرب.
ثم جاء أول الشهر. اهتز المخيم بتحضيرات مختلفة. كانت الأبواق الفضية تُنفخ نفخات طويلة، معلنة بداية شهر جديد. كانت القرابين هنا مختلفة تماماً. ثيران وكباش وحملان، بأعداد كبيرة، مع مقادير هائلة من الدقيق والزيت والخمر. وقف أليآف منذهلاً وهو يحصي مع شيخه ما سيُقدم: ثوران وكبشان وسبعة حملان… كميات من الدقيق تُخلط بزيت، وأمثالها من الخمر تُسكب. كان المذبح يبدو وكأنه لن يتسع. الدخان يتصاعد عموداً ثخيناً، والرائحة تعم المخيم. كان عيداً، ولكن ليس كالأعياد التي يعرفها الناس. كان عيداً للرب. محرقة، رائحة سرور، ذبيحة خطية واحدة من التيس. كل هذا في أول كل شهر، كتذكير بأن الزمن نفسه، دوراته وأطواره، ملك للرب، ويجب أن يُقدس له من أوله.
وصلت التعليمات إلى أيام الاحتفال الكبرى. الفصح، حيث يمتزج ذكرى الخلاص العجائبي من مصر مع طقوس محرقة دقيقة. وأعياد الأسابيع، وعيد الأبواق، ويوم الكفارة العظيم المهوب، وعيد المظال. لكل منها نَسَقُهُ، وأعداده، وروحه. في يوم الكفارة، كان الجو يغمره صوم وصلاة ورهبة، والقرابين كانت للتكفير، وكان الدم يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة. في عيد المظال، كانت القرابين تزداد يومياً، من ثلاثة عشر ثوراً في اليوم الأول إلى سبعة في اليوم السابع، مع ما يرافقها من حملان وكباش. كانت وكأنها موجة متصاعدة من التسبحة، ثم هابطة بنعمة.
كان أليآف يتعلم. لم تعد الحركات مجرد طقوس. كل ذبيحة كانت حرفاً في لغة أعمق من الكلام. الدقيق والزيت، قوت الحياة اليومي، يُقدَّم. الخمر، فرح القلب، يُسكب. الدم، الحياة نفسها، يُعاد إلى مالكها. النار، التهام المقدَّم، وصعوده كدخان إلى العلو. كانت المحرقة كلها ذهاباً، عطاءً كاملاً، لا يُسترد شيء منه. كانت تقول: “كل ما لي هو لك”.
وفي المساء، بعد أن تنطفئ النار ويبرد المذبح، كان أليآف يجلس مع شيخه الكاهن خارج الدار. وكان الشيخ، بعينين تجرّبتا سنين البرية، يقول: “انظر يا بني. هذه ليست مجرد ذبائح. هذه مواعيد. كل حمل صباح يذكّرنا بأن رحمة الرب جديدة في كل صباح. وكل حمل مساء يؤكد أن رعايته لا تنام. والأعياد تنظم زماننا كعلامات على طريقه معنا. هو إله النظام، إله اللقاء. هو لا يريد أن ننساه في زحام الحياة، ولا في فراغ البرية. لذلك جعل له مواعيد معنا. نلتقي به هنا، عند النار، عند الدم، عند رائحة السرور”.
وأدرك أليآف أن البرية القاحلة، برياحها العاتية ولياليها الباردة، لم تكن مكاناً للفراغ، بل لامتلاء آخر. امتلاء بجدول زمني مقدس، بنَفَس متواصل من العبادة، برائحة تملأ الفضاء بين الأرض والسماء. كانت الخيمة، بهذه النيران المتواصلة، هي المركز الحقيقي للجماعة، النقطة الثابتة في ترحالهم. والله كان هناك، يلتقي بهم، صباحاً ومساءً، في أول الشهر وفي أعيادهم، ليس كفكرة مجردة، بل كمن يُعد له مائدة، ويُسرّ بلقائهم.
كانت تلك هي الشريعة. لم تكن ثقلاً، بل إيقاعاً للحب. نَفَسٌ مقدس، ينبض في قلب البرية.