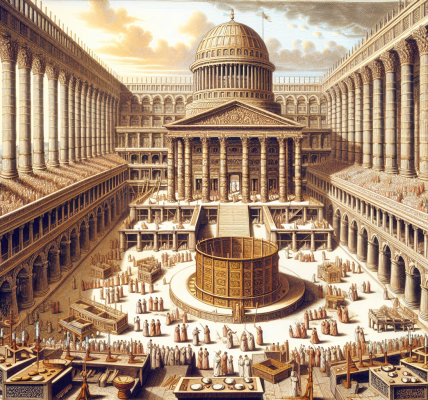كانت الشمس تميل نحو المغيب، وتنسحب ظلال السور العظيم لمدينة أورشليم طوالية على الحجارة القديمة. جلستُ على مصطبة قرب باب العمود، وأنا أتأمل السحب القرمزية والذهبية التي حَكتْ بها الأصابع الخفية رداء السماء. في ذلك الهدوء، حيث يتحول ضجيج النهار إلى همسٍ مسائي، تذكرتُ كلمات أبينا داود، تلك التي هزتْ قلبي مراراً: “احمدوا الرب لأن الترنم لحسنٌ. لإلهنا فمرنمٌ لأنه لذيذ. المحسن لبني كوراث.”
مر بي شيخٌ من أحبار اللاويين، متكئاً على عصاه، وخطواته بطيئة كوزن تاريخ طويل. وقف قليلاً، ونظر إلى السماء، ثم إلى السور، ثم إلى وجهي. قال بصوته الخشن الذي يحمل نغمة الصلاة والتأمل: “أترى هذه الحجارة، يا بُني؟ كل واحدة منها تحكي قصة جُرحٍ شُفي، وقصة ساقٍ كُسرتٍ وربطها الرب.”
أومأت برأسي، وهو استدار ليواصل طريقه، لكن كلماته بقيت معي، كبذور سقطت في تربة الفكر. نعم، لقد رأيتُ ذلك بعينيَّ. رأيتُ المدينة بعد العودة من السبي، محطمة الأوصال، مكسورة القلب كأرملة في سوق العبيد. ولكن الرب بنى أورشليم من جديد. جمع مشتتها كراعٍ يجمع خرافه المتبددة. كم كان مشهد العائدين مؤثراً، وهم يحملون في عيونهم ذكريات بابل، وفي قلوبهم رجاءً جديداً. كان الرب يربط جراحهم، وهو وحده يعلم عمق كل كسر.
رفعت عيني إلى السماء. كانت النجوم تبدأ في الظهور، واحدة تلو الأخرى، كأنما يد خفية تنثر اللآلئ على رداء أزرق قاتم. كم هو عظيم ربنا! هو الذي يحصي عدد النجوم، ويسمي كل واحدة منها باسمها. تذكرت ليالي الصحراء، عندما كنتُ راعياً صغيراً، كنتُ أنظر إلى هذه المجرة المتلألئة وأرتعب من عظمتها. ولكن الكاتب المزمور علمني أن الذي خلق هذه العوالم الهائلة، هو نفسه الذي يهتم بالقلب المنكسر. إنه يرفع الودعاء، ويحطم الأشرار إلى الأرض. إنه لا يكتفي بتسخير الكون، بل ينحني إلى الإنسان.
سمعتُ في البعيد صوت جرس خروف يقرع، ثم آخر، ثم آخر. كانت القطعان تعود إلى الحظائر. وفجأة، هبت نسمة باردة حاملةً عبير الزعتر البري وإكليل الجبل. تذكرتُ كلمات المزمور: “يُغطي السماء بالغيوم، ويُهيئ للمطر الأرض. يُنبت على الجبال عشباً.” كم هذه الكلمات حية! لقد شهدتُ سنين الجفاف، عندما تشققت الأرض وتاقت إلى قطرة ماء. ورأيتُ كيف يأتي الرب بالغيوم من أقاصي البحر، سوداء مثقلة بالرحمة، فتسقي الأرض حتى تختنق منها الأودية، وتنبت المراعي للبهائم. حتى الغربان الصغار التي تصرخ – هو يعتني بها، ويطعمها. أليس هذا برهاناً على لطفه الذي لا يحده حد؟
نهضت من مصطبتي، وبدأت أمشي نحو بيتي داخل المدينة. مررت بسوق الخضار الفارغ الآن، إلا من بعض الأوراق المتناثرة. تذكرت مواسم الحصاد. يا للفرح الذي يملأ القلوب عندما تمتلئ المخازن بالقمح والشعير والزيتون والعنب! إنه هو الذي يرسل كلمته إلى الأرض، فتجرى كلمته بسرعة. هو الذي يعطي الثلج كالصوف، وينشر الصقيع كالرماد. يلقي جَمده كفتات الخبز. من يقف أمام برديه؟ ثم يرسل كلمته فتذوب هذه كلها. تهب ريحه فتجري المياه. أليس هذا دليلاً على سيطرته المطلقة على الطبيعة، وتدبيره الحكيم لفصول السنة؟
وصلت إلى باب بيتي، وكان أولادي يلعبون في الدار. نظرت إلى وجوههم المشرقة، وإلى زوجتي التي تعد المائدة. دخلت وقلت في نفسي: “ليس بالقوة يتشجع الجبار، ولا بالكثرة يقوى البطل. الرب يُسرُ بالذين يتقونه، بالذين يرجون رحمته.” كم نحن ضعفاء! كم نحن محتاجون! لكن قوتنا الحقيقية ليست في أسلحتنا أو جيوشنا، بل في اتكالنا على ذاك الذي خلق السموات والأرض.
قبل أن أجلس للعشاء، وقفتُ عند النافذة الصغيرة. كانت أورشليم هادئة الآن تحت جنح الليل. سمعتُ صوت صلاة خافتة يأتي من بيت مجاور. إنه إلهنا، إله إسرائيل، الذي يُسبح في كل جيل. هو الذي يقوي أقفال أبوابنا، ويبارك بنينا فينا. هو الذي يُعطي السلام في تخومنا، ويشبعنا من دسم الحنطة. أليس هذا هو الرب الذي نعبده؟
جلستُ مع عائلتي، وكسرنا الخبز. وفي قلبي ترنيمة شكر جديدة، لا لأن الرب أعطى فقط، بل لأنه هو نفسه صالح، ولأن مراحمه إلى الأبد. إن ترنيمتنا له ليست مجرد واجب، بل هي لذيذة، لأنها تأتي من قلب عارف بعظمته ورحمته. هو الذي يلمس النجوم بأصابعه، وهو نفسه يربط قلوبنا المنكسرة. فهل هناك أعظم من هذا الإله؟