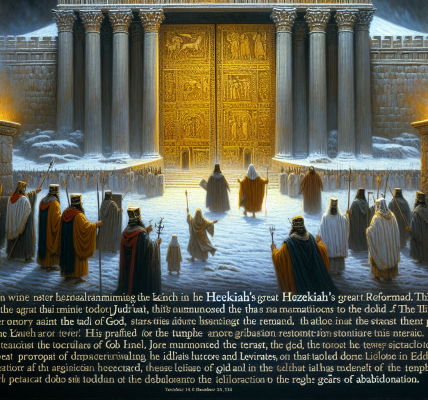عاد يسوع من نهر الأردن، وكان الروح يملأه ويقوده. لكن هذه القيادة لم تكن إلى طريق مُعبَّد، بل إلى مكان خشن وقاسٍ، إلى برية شاسعة تمتدّ بين التلال الجرداء والحجارة المحترقة تحت شمس فلسطين الحارقة. هناك، في ذلك الصمت الثقيل المليء بهسّ الرياح الحارّة وزئير وحوش خفية، مكث أياماً أربعين، يواجه شيئاً أقسى من الجوع والعطش.
كان الجوع قد أصبح كائناً يعيش في أحشائه، يشبه ثعباناً متعرّجاً يلتهم من قواه. كانت الصخور حوله تشبه أرغفة الخبز الداكن في ضوء الغروب، وكان إغراء تحويل الحجر إلى خبز يتراءى له كحلّ معقول. وصوتٌ داخلَ ذهنه، صوتٌ ناعمٌ ومُلحٌّ، همس له: “إن كنت ابن الله، فقل لهذا الحجر أن يصير خبزاً”. لكنَّ ذكرى كانت أقوى من جوعه: ذكرى كلمات قديمة تدفقت من فم موسى على جبل نبو، “ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان”. كان هناك خبز آخر، كلمة خارجة من فم الإله نفسه، تُطعم الروح وتشبع القلب. فجاء رده، بصوت أجشّ من شدة العطش، لكنه ثابت: “مكتوب أنَّ الإنسان لا يحيا بالخبز وحده”.
لم ينته الأمر. فالذي يجرب لا ييأس بسرعة. فأخذه الروح، أو ربما سمح هو نفسه بأن يُؤخذ، إلى علوّ شاهق. وفجأة، دون أن يفهم كيف، رأى كلّ ممالك المسكونة منتشرة تحت قدميه كسجّاد ملون ومتلألئ. رأى المدن البيضاء والطرقات المزدحمة، الموانئ المليئة بالسفن، القصور المترفة والحصون المنيعة. رأى المجد البشري بكل بهائه وقوته وعريهِ الأخلاقي. ومرة أخرى، نفس الصوت، لكن هذه المرة بلهجة عظيمة، كما لو كان يقدم له العالم كهدية: “لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهما، لأنهما قد دفعا إليَّ، وأنا أعطيه لمن أريد. فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع”. صمت يسوع لحظة. كان المنظر مبهراً حقاً. كان بإمكانه أن يكون قيصراً على كل هذا، حاكماً عادلاً، مصلحاً اجتماعياً عظيماً. كم من معاناة يمكن أن يخففها! لكن السجود؟ السجود لغير الذي منه كل شيء؟ هزّ رأسه، وكلمات المزامير تعلو في ذاكرته، كلمات تكرست في قلبه منذ طفولته في الناصرة: “مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد”.
لم يستسلم المجرب. فقاده إلى أورشليم، إلى أعلى جناح الهيكل. وقفا معاً حيث الهواء منعش والمنظر مهيب. تحت أقدامهم كانت ساحات الهيكل تغصّ بالحجاج والكهنة، أصوات الصلوات والضحكات وصراخ الباعة تعلو كموج البحر. وكان الصوت يقول له، متكئاً على نفس الكتب المقدسة: “إن كنت ابن الله، فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل. لأنه مكتوب: إنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك. وعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجلك”. كانت التجربة هنا أخطر، فهي لا تستخدم الجوع أو الطمع، بل استخدام موعد الله نفسه، إغراء أن يختبر محبة الآب بطريقة دراماتيكية، أن يفرض معجزته، أن يجعل من نفسه مسيحاً مذهلاً يبهر الجموع. تنهّد يسوع. كم كان من السهل أن يقفز! ليتجمع الجميع حول جسده السليم، وليعلنوه ملكاً على الفور. لكن الإيمان ليس لعبة استعراض. فكان رده أخيراً، حاسماً: “قيل: لا تجرب الرب إلهك”.
وبعد أن أكمل المجرب كل تجربة، فارقه إلى حين. كان ذلك “إلى حين” كلمة ثقيلة، تعني أن المعركة لن تنتهي هنا. لكن الآن، جاءت الملائكة تخدمه. لم نعرف كيف خدمته. ربما قدّمت له ماءً بارداً من نبع خفي، أو خبزاً دافئاً كخبز إيليا. المهم أنه وجد قوّة جديدة.
عاد إلى الجليل، وقوّة الروح تحمله. وبدأت أخباره تنتشر في كل الكورة المحيطة. وصل إلى الناصرة، بلدته، حيث كل حجر ووجه كان يعرفه. وفي يوم السبت، دخل المجمع كما كانت عادته. وقام ليقرأ. قدّموا له سفر إشعياء النبي. ففتح السفر ووجد الموضع المكتوب: “روح الرب عليَّ، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في حرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة”. ثم طوى السفر وسلّمه للخادم وجلس. وكانت عيون الجميع في المجمع شاخصة إليه. كانوا ينتظرون تفسيراً، عظة لطيفة عن أيام المجد القديمة. لكنه فتح فمه وقال: “اليوم قد تمّت هذه الكتابة في مسامعكم”. كان الصمت يصم الآذان. ثم بدأ الهمس: “أليس هذا ابن يوسف؟”. وكما تتوالى قطع الدومينو، بدأت الأسئلة والاعتراضات تخرج. طالبوه بمعجزة هنا، في بلدته، مثلما سمعوا أنه فعل في كفرناحوم. فتكلم بكلمات قاسية عن الأنبياء الذين لم يقبلهم أهل بيوتهم، وعن إيليا الذي أرسل إلى أرملة في صيدا، وعن أليشع الذي شفى نعمان السرياني لا أحد من برص إسرائيل. هنا اكتمل الغضب. تحولت الدهشة إلى حنق. لم يعد يرون ابن النجار الوديع، بل رأوا رجلاً يتحدى عصبيتهم ويفضح ضيق أفقهم. قاموا بهياج، وأخرجوه من المدينة، وساقوه إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، لينفّذوا فيه حكم الرجم. لكنه اجتاز وسطهم ومضى. كانت هناك هالة حوله، كرامة وسلطان، جعلتهم يتخلون عن طريقه. ومضى في طريقه، إلى كفرناحوم، حيث ستكتب الفصول التالية.