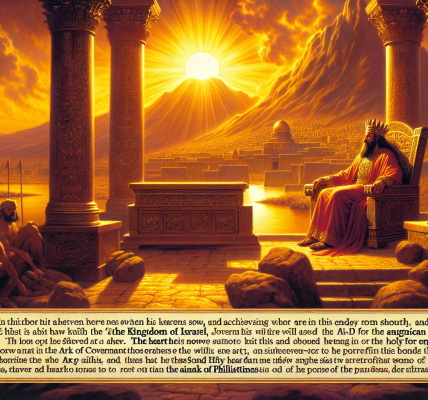كان الظلام في الزنزانة رطبا وثقيلا، كقطعة قماش مبتلة تخنق الأنفاس. لم يكن ظلام الليل فحسب، بل ظلام الحجر البارد، وظلام البعد عن الأحبة، وظلام الانتظار المجهول. على طاولة خشبية مهتزة، بجوار إبريق ماء شاحب، امتدت رقعة من الرق تحت يد رجل كتبتها بسكين حاد. كانت يد بولس، المتشابكة العروق، تتحرك ببطء لكن بيقين. الألم في ظهره من الجلد، والضعف في جسده من السفر، لم يثنِ القلم عن السير. كان يكتب إلى أحبائه في فيلبي، إلى تلك الجماعة الصغيرة التي كانت قلبه في مكدونية.
توقف لحظة، ورفع رأسه نحو الفتحة الصغيرة العليا حيث كان نور النهار يتسلل خجولا. تذكر وجوههم: ليديا بائع الأرجوان، والحارس الذي اهتزت أركان حياته، والعبيد الذين وجدوا حرية لم يعرفوها في ظل الآلهة الكثيرة. كم كانت قلوبهم ممتلئة محبة! ولكن، كما هي طبيعة البشر، بدأت الخلافات تزحف، خفية في البداية، ثم كشقوق في جدار حديث العهد. نزعات نحو التفرد، همسات حول من هو الأعظم في الخدمة، غيرة هنا، شعور بالإهمال هناك. لم تكن شرورا فجة، بل كانت روائح خفية لكبرياء القلب البشري المألوف.
أغمض عينيه وتنهد تنهدة خرجت من أعماق أحشائه. لم يكن ليكتب لهم موعظة جافة. لا. كان يجب أن يزرع الحقيقة في تربة قلوبهم كما يزرع الفلاح البذرة في الأرض الطيبة. فبدأ يكتب، وكلماته كانت كالندى الهادئ: “إِنْ كَانَتْ لِيْ بِأَيَّةِ طَرِيْقَةٍ تَسْلِيَةٌ فِي الْمَسِيْحِ، إِنْ كَانَتْ لِيْ تَعْزِيَةٌ مِنَ الْمَحَبَّةِ…” شعر بحرارة غريبة تملأ صدره. كان الموضوع أكبر من مجرد نصيحة للوحدة. كان يدور حول السر الأعظم، النموذج الأسمى، اللغز الذي هز السماوات والأرض.
توقف قلمه مرة أخرى. كيف يشرح هذا؟ كيف ينقل ما لا يمكن نقله؟ نظر إلى جدران السجن، وكأنه يبحث عن صورة توضيحية. ثم خطرت له فكرة. بدأ يصف ليس فكرة مجردة، بل شخصا. “لِتَكُنْ فِيْكُمْ هَذِهِ الْفِكْرَةُ الَّتِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ أَيْضاً.” هكذا بدأ. لم يقل “افعلوا كذا” فحسب، بل قال “ليكن فيكم هذا الفكر، هذا المنطق الداخلي، هذا التوجيه الأساسي للكون”.
وانساب القلم على الرق، وكأنه يسحب خيط نور من ذاكرته ومن الوحي الذي يملأ روحه. كتب عن ذاك الذي، وهو في “صُورَةِ الله”، لم يعتبر مساواته لله غنيمة يتمسك بها. هنا، تأمل بولس في الكلمات. لم تكن المساواة لله شيئا يمكن أخذه، بل كانت هيئة كينونته منذ الأزل. لكنه، بحرية مطلقة وحب لا يسبر غوره، “أَخْلَى نَفْسَهُ”. لم ينتزع منه شيء، بل هو أخلى نفسه طوعا. تخلى، ليس عن لاهوته، بل عن مجده الظاهري، عن امتيازات السيادة التي كانت حقه. نزل. نزولا لا يمكن للعقل البشري أن يستوعب عمقه.
أخذ بولس يستعرض هذا النزول المتعمد، درجة درجة، وكأنه يروي ملحمة سماوية. “آخِذاً صُورَةَ عَبْدٍ”، الكلمة التي تهمس بالملكوت تلبست ضعف الجسد. “صَائِراً فِي شِبْهِ النَّاسِ”، لم يأتِ كملك متجبر، بل كإنسان من لحم ودم، يعرف الجوع والتعب والألم. ثم الذروة المروعة: “وَإِذْ وُجِدَ فِي الْهَيْئَةِ كَإِنْسَانٍ، وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ”. وقف القلم عند هذه الكلمة: الموت. ولكن لم يكن أي موت. كان موتا من نوع خاص، موتا كان عارا في نظر الرومان، ولعنة في نظر الشريعة: “مَوْتَ الصَّلِيْبِ”.
شعر بولس بدمعة حارة تنساب على خده. هو، السجين الذي قد يواجه هذا المصير نفسه، كان يكتب عن سيده الذي اختاره طوعا. الصليب! آلة التعذيب الرومانية القذرة، موت الخارجين عن القانون والعبيد. في هذا المكان، في ذروة الإذلال والألم، وضع الابن نَفْسَه. الأطاعة هنا لم تكن سلبية، بل كانت نشيطة، كانت قبولا كاملا لمشيئة المحبة حتى النهاية المرة.
ثم، كما يتحول اللحن من سلم ثانوي حزين إلى سلم رئيسي مجيد، انعطف القلم في يده. “لِذلِكَ رَفَّعَهُ اللهُ أَيْضاً”. الرفعة لم تكن تعويضا فحسب، بل كانت نتيجة حتمية لهذا النزول. كان التمجيد هو الوجه الآخر للتجريد. “وَأَعْطَاهُ اسْماً فَوْقَ كُلِّ اسْمٍ”. في عالم كان الاسم يعبر عن الكينونة والسلطان، أعطي له الاسم الذي يختصر كل سلطان، الاسم الذي “يَحْنِيْ بِهِ كُلُّ رُكْبَةٍ” في السموات وعلى الأرض وتحت الأرض. كل ركبة: ركبة القيصر الجبار في قصره فوق التل، ركبة الفيلسوف المتكبر في مدرسته، ركبة العبد المسحوق في الحقل، ركبة الشيطان المتمرّد في ظلماته. الجميع، طوعا أو كرها، سيعترفون. و “كُلُّ لِسَانٍ” سيصرح، من قلب المسبح أو رهبة الحقيقة القاهرة، أن “يَسُوْعَ الْمَسِيحُ هُوَ رَبٌّ”، ليس لمجد الشخص فحسب، بل “لِمَجْدِ اللهِ الآبِ”.
نظر بولس إلى ما كتبه. كانت القصيدة اللاهوتية قد اكتملت. لكن الرسالة لم تنته. فالقصيدة لا تقال للإعجاب، بل للعيش. عاد إلى أحبائه في فيلبي، إلى خلافاتهم الصغيرة. “فَإِذاً يَا أَحِبَّتِي… اعْمَلُوا بِخَوْفٍ وَرِعْدَةٍ”. الخوف ليس ذعرا، بل هيبة مقدسة أمام عظمة ما نُدعَوْ إليه. “لأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَامِلُ فِيْكُمْ”. ها هي النعمة! ليس جهدكم وحدكم، بل الله نفسه يعمل في داخلكم، يمنحكم الإرادة والفعل. العمل؟ “لأَجْلِ الْمَسَرَّةِ”. ليس من واجب ثقيل، بل من محبة ممتلئة فرحا.
ثم جاءت التطبيقات العملية، ناعمة وحاسمة: “افْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ بِدُونِ دَمْدَمَةٍ وَجِدَالٍ”. الدمدمة، تذمر القلب. الجدال، تحاجج الشفتين. كلاهما ينبعان من روح الأنا المركزية على ذاتها. ولكنهم، في وسط جيل معوج، سيكونون “بِلاَ لَوْمٍ”، أنقياء في قلوبهم وسلوكهم. “بُناَنَ اللهِ” في عالم مظلم. سيحملون “كَلِمَةَ الْحَيَاةِ”، تلك الكلمة التي كتب عنها للتو، كأنوار في ليل دامس. عندها، في يوم المسيح، سيكون فخره الحقيقي: أنه لم يجهد عبثا، ولم يركض سدى.
وضع بولس القلم. كان الألم في ظهره ما يزال موجودا، والظلام في الزنزانة لم يتراخ. ولكن شيئا ما اكتمل. كان قد غرس بذرة الحقيقة في التربة. ليست حقيقة نظرية، بل حقيقة حية، متجسدة في شخص. لقد أراهم الطريق: النظر إلى المسيح. النزول. الخدمة. نسيان الذات. الثقة بأن الرفعة تأتي من الله، لا من انتزاعنا إياها. في ذلك المسار وحده، ستنصهر خلافاتهم، وتتوحد قلوبهم، ويشع نورهم في مكدونية.
سحب الرققة نحوه، وبدأ يكتب التحيات الأخيرة، وكلمات الامتنان على العطية التي أرسلوها له. حتى في شكرهم، كان يرَى نموذج المحبة المتضحية. وأخيرا، مع “نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوْعَ الْمَسِيحِ مَعْ رُوْحِكُمْ”، ختم الرسالة. كان السلام الحقيقي، سلام المصالحة مع الله ومع بعضهم البعض، قد أرسل إليهم. ليس سلام العالم، بل سلام الصليب، سلام النزول الطوعي، السلام الذي يملأ القلب حتى في زنزانة روما الظلماء.