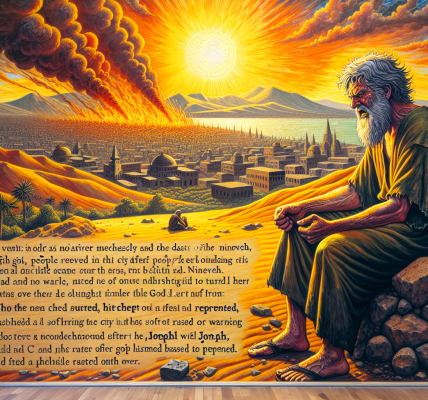كانت حرارة الشمس تتراجع خلف جبل نيبو، مُطلقةً ألواناً من الأرجوان والذهب على خيام بني إسرائيل المنتشرة في السهل. في خيمة الاجتماع، وقف أليعازر بن هارون، بعد أن تولى مهام أبيه، يستشعر ثقل الثوب الكهنوتي على كتفيه. كان الهواء محملاً برائحة تراب الصحراء المحروق بالشمس، وبرائحة بخور الصباح الذي لا يزال يعبق في رئتيه.
كان اليوم الأول من الشهر السابع، يوم الهتاف. لكن قلبه لم يكن مملوءاً بالهتاف. لقد كان إرهاق الرحلة، وهمهمة الشعب المتذمر، وثقل القيادة بعد موسى، جميعها تضغط على صدره كحجر رحى. نظر إلى الخارج حيث كان اللاويون يجهزون الثيران والكبش والحملان. كانت الذبائح اليوم، كما أوصى الرب لموسى، أكثر تفصيلاً. عيد لا يكتمل بذبيحة واحدة، بل بفيض منها، كأن الرب يريد أن يغمرهم بنعمته حتى في وسط التيه.
تقدم البكر من القبيلة بقرة شابة، عيناها واسعتان وهادئتان. رفع أليعازر يديه، وشعر بخشونة الصوف تحت أصابعه. قبل أن يذبحها، تذكر كلمات أبيه هارون: “ليس عن دمائها وحد نسأل، بل عن قلوبنا التي يجب أن تسيل ندامة ومحبة مع الدم”. سمع صوت السكين وهي تخترق الجلد، ثم تدفق الدم الدافئ إلى الطست النحاسي. رش الدم على المذبح بسبع رشقات، كل رشقة تذكرته بخطية تحتاج لغفران، ونعمة تفيض سبعة أضعاف.
لم تكن الذبائح مجرد طقوساً بلا روح. فبينما كان اللحم يشتعل على النار، متحولاً إلى دخان يصعد رائحة سرور للرب، نظر أليعازر إلى الجماعة. رأى عيوناً متعبة ولكنها مليئة رجاء، أيدٍ خشنة من العمل ولكنها مرفوعة بالصلاة. هذه الذبائح لم تكن لتكفي عن خطاياهم وحدها، بل كانت ظلاً للذبيحة الحقيقية التي ستأتي، الحمل الذي يرفع خطية العالم.
وفي اليوم العاشر من الشهر، يوم الكفارة، كان الجو مختلفاً. صمت ثقيل يخيم على المحلة. لم تكن هناك أصوات عمل أو أطفال يلعبون. حتى أغنام القبائل كانت تثغو بصوت خافت. في قدس الأقداس، حيث يدخل رئيس الكهنة وحده مرة في السنة، كان أليعازر يقدم دم تيس الخطية عن نفسه وعن الشعب. كان الظلام يكتنف المكان، لا يخترقه سوى ضوء المصباح الذهبي. عند خروجه، كان وجهه شاحباً، ولكن في عينيه بصيص سلام غريب. لقد لمس، ولو للحظة، ثمن الغفران الهائل.
ثم جاء عيد المظال، سبعة أيام من الفرح والوفرة. كانت الخيام تصنع من أغصان النخيل والصفصاف، تذكرهم بسنوات التيه، ولكن أيضاً بحماية الرب التي كانت مظلتهم. كل يوم، كانت الذبائح تتكرر: ثلاثة عشر ثوراً في اليوم الأول، ثم اثني عشر، ثم أحد عشر، حتى سبعة في اليوم السابع. كانت الأعداد تتناقص، كأن الرب يقول: “فرحكم يكمل شيئاً فشيئاً، حتى يصل إلى الكمال”. وكان الشعب يأكلون، ويشربون، ويسبحون، ويرقصون تحت النجوم.
في اليوم الأخير، اليوم الثامن، وقف أليعازر وهو يبارك الشعب. نظر إلى وجوههم المضيئة بنيران المواقد، تلمع عيون الأطفال بلوعة الرمان والعسل. تذكر والده هارون، وتذكر موسى على الجبل. ثم فهم. كل هذه الثيران والكباش والحملان، كل هذه الدموع والدماء والدخان، كلها كانت حروفاً في قصة حب إلهي عظيم. قصة غفران يبحث عن خاطئ، وفرح ينتظر من يعثر عليه، وذبيحة واحدة كاملة ستأتي في ملء الزمان لتنهي كل الذبائح.
نزل الندى على المحلة، كطلسم من الفضة تحت ضوء القمر. وكان صوت أليعازر يرتفع بالبركة الأخيرة: “يباركك الرب ويحفظك. يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك. يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاماً”. وكان السلام، سلام الله الذي يفهم كل العقل، يحل على المحلة، بينما كان دخان المحرقة الأخير يصعد كصلاة صامتة، تحمل قلب شعب تائه، وقلب كاهن متعب، إلى قلب الله الذي لا يتعب ولا يمل الغفران.